خمس عشرة مراجعة نقدية في "نبيذها أزرق ويُؤنس الزجاج" لآمال نوار
- آمال نوار

- Jan 27, 2019
- 58 min read
Updated: Feb 1, 2019
بقلم: جهاد الترك (المستقبل)، عابد اسماعيل (الحياة)، حسين بن حمزة (الأخبار)، عناية جابر (السفير)، زينب عسّاف (النهار)، نصر جميل شعث (إيلاف)، راسم المدهون (النهار)، شادي علاء الدين (ملحق النهار الثقافي)، نور الدين محقق (جهة الشعر)، رامي الأمين(الحياة)، محمد العشري (النهار)، اسكندر حبش (السفير)، باسم المرعبي (إيلاف)، محمد جميل أحمد (سودانيز أونلاين)، منصف الوداعي صالح.

(1)
في الغياب يتوحد العالم واللغة فيولد أحدهما من الآخر
“نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج” نصوص جديدة للشاعرة اللبنانية آمال نوار
جهاد الترك (لبنان)
المستقبل - الاثنين 16 تموز 2007
هشة ومبتذلة هي اللغة الشعرية. وقد تغدو ساقطة إذا ما انقلبت على نفسها بفعل ما تنطوي عليه من هامش واسع من المناورة والانتهازية والاحتيال كذلك. العلة في الشاعر، على الأرجح، نتيجة لما يخيّل إليه بأنه يستدرج اللغة إلى حيث يريد. الى حيث يحقق فوزاً استثنائياً في تفجيرها من الداخل لاعادة اللحمة بين أشلائها أو ما يتبقى من بقاياها. ومع ذلك، يبدو أن المرض الخبيث يكمن في اللغة أكثر منه في الشاعر. غالباً ما يدفع هذا الأخير ضريبة إلزامية، وثمناً باهظاً لهذا الخبث القاتل الذي تمارسه عليه بوقاحة. توحي اللغة إليه بأنه على قاب قوسين أو أدنى من بلوغ التعبير الأقصى وهو يتألق في دائرة الحلم. هذه هي الخديعة الأولى التي تتعاقب بعدها سلسلة من الأكاذيب الجميلة. توهمه بأن تلقي في مخيلته نتفاً من صور شعرية مغايرة. تغريه بذلك. ينبهر الشاعر. يصدق بأن اللغة اختارته وحده لتمنحه بركتها الأبدية. اللغة تضحك عليه في سرها. تسخر منه. تشمت منه لأنها تمكنت من خداعه. في حقيقة الأمر، لا تستسيغ اللغة هذا النوع من البراءة الساذجة. تنفر منها. والأغلب انها تحتقرها، لأنها تتطلع إلى موقف آخر للشاعر ينصرف فيه إلى عدم الانزلاق بما تفيض عليه من صور أولية. تريده أن يصطحب معه إزميله على الدوام. يحفر فيها عميقاً من دون رحمة ليزيل عنها القشور والصدأ والغبار الكثيف لا أن يسجل اعجاباً منقطع النظير بالفتات القليلة التي تجود بها عليه. معادلة معقدة، على الأرجح، بين الشاعر واللغة. وغير متكافئة تحقق فيها اللغة امتناعاً قاسياً عن تسليم نفسها بأبسط السبل وأهونها.
معادلة الرؤية واللغة
قد تبدو هذه المعادلة ضرورية، على الأغلب، لقراءة متأنية لنصوص الشاعرة اللبنانية، آمال نوار، بعنوان “نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج” الصادرة عن “دار النهضة العربية”، بيروت 2007. ثمة في هذا الكتاب ما يستوقفنا، مطولاً، عند عتبات العلاقة الصعبة التي تقيمها الشاعرة بين الرؤية واللغة، بين الصورة ومفرداتها، بين اللغة واللغة نفسها، بين الحلم ومكوناته. نلحظ هذه الأجواء الملبدة بشروط متبادلة مرهقة بين الطرفين. لا اللغة تقدم فروض الطاعة بسهولة. ولا الشاعرة تبدي استسلاماً سهلاً للغة. على النقيض من ذلك، تظهر ممانعة مثيرة للاعجاب تنطوي، على الأغلب، على نزاع حقيقي مع المفردة الواحدة، أو العبارة، قبل أن تضعها في موقعها الملائم في النص. على هذا الاساس، تبدو معادلة الخديعة والانزلاق على طريق الايحاء الكاذب للشعر واضحة في سائر نصوص الكتاب. وهذا ذليل، على أن آمال نوار قد حسمت أمرها في التصدّي لمغريات اللغة قبل أن تتمكن منها هذه الأخيرة فتحيل نصوصها ضرباً من البهرجة الشكلية.
مهمتان تتكبدهما الشاعرة، في هذا السياق. أولاهما وأكثرهما ارهاقاً وقلقاً، هي الاصطدام العنيف بجدار اللغة وهي تشق طريقها صعوداً لملاقاة الصور الشعرية وهي تتكون في الذاكرة المنفتحة على اشراقات الحلم. قلما نلحظ، في هذا المجال، تدفقاً تلقائياً للمعنى وهو يتحول من صورة إلى أخرى، أو من شكل إلى آخر. لا نعثر على توجه من هذا القبيل. اذ لا تنصاع الكاتبة لأول اشارة تردها من اللغة. قد تستخدم هذه الايماءة حافزاً قوياً يشبه شرارة الاشتعال للحفر في اللغة أكثر منها الانقياد السلس وراء اغراءاتها التي تبدو عصية على المقاومة، في معظم الأحيان. كلما أوغلت الشاعرة في تعقب الصور المبتكرة، غاصت في جوف اللغة، في متاهاتها المتعددة، في منافيها القريبة والبعيدة. يتحول الحلم، في هذه المعادلة هبوطاً متروياً في قعر اللغة بحثاً عن اساسات الرؤيا في تربة اللغة وليس في أجواء الحلم المتناثرة في كل الأمكنة والأزمنة. الرؤية البعيدة في هذه النصوص هي أكثر اقتراباً مما نعتقد من المفردة قبل أن تفتح خزائنها ليغرف الحلم منها ما يناسبه. ومع ذلك لا تنطلق آمال نوار، في لعبتها المفضلة هذه، من رغبة عارمة في تحدي اللغة للكشف عن اسرارها الصامتة. ثمة ما يجعل من هذه اللعبة المدروسة أمراً مفعماً بلهيب البحث عن أسرار اللغة وهي تتشكل في اطار المجهول قبل أن تتقمّص الصور المتضاربة في فضاء الذاكرة. الاصطدام العنيف بجدار اللغة هو اصطدام، في الوقت عينه، بجدار الصورة الشعرية. يبقى احدهما معلقاً بانتظار ان يتمكن هذا أو ذاك من فتح كوة في الجدار. كلما تسللت الشاعرة الى الطبقات السفلى للمعنى اللغوي حققت صورها الشعرية ارتقاء نحو الأعلى. وكلما انشدت نحو الاسفل بفعل الجاذبية، عادت لتتحرر منها. إذ يتلقى المعنى، في هذه الحال، دفقاً قوياً وحيوية بالغة ليتحول من صورة إلى أخرى، من فضاء إلى آخر، من بريق إلى آخر.
الجاذبية ونقيضها
الجاذبية ونقيضها، هما على الأرجح أبرز ما يمنح هذه النصوص هويتها الجميلة والمتميزة. يساعدها، في ذلك، أن الشاعرة ترقب الصورة، في مناخاتها المتشكلة، واللغة وهي تتكسر على نحو لا ينقطع، من موقع بعيد. والأغلب من مناطق نائية قاصية. فهي تنظر الى اللغة من وراء الكواليس. تراها بوضوح. تتشبع بها. تستمتع بمشاهدتها، وهي تتعرى من حجارتها الخرساء. كذلك ترقب صورها الشعرية من الموقع عينه. عين على هذه، وأخرى على تلك. بينما لا تحس بوجودها، لا اللغة ولا الصور المنبثقة منها. رؤية من طرف واحد، بدليل أن أغلب النصوص، ان لم يكن كلها، قد كتبت من حيث يبدو الغياب هو المحرك الخفي الذي يمسك بقواعد اللعبة. الشاعرة هي الغائبة الكبرى في النصوص جميعاً. ومع ذلك. فهي الأكثر حضوراَ. كلما غابت، في هذا النص أو ذاك، وكلما انسحبت من دائرة الضوء ، بدت الصورة الشعرية أكثر حباً للحياة، وأقدر على الصمود والبقاء. في هذا السياق الذي تتجاذبه هذه الجدلية الصامتة، تنتفي اللعبة، بما هي شكل يتحكم بمزاج الشاعرة، لتصبح تلقائياً شرطاً اساسياً وحقيقياً لاستدعاء الشعر إلى النص المتحول بايقاع سريع.
الغياب، على هذه الخلفية، لا يعود انكفاء عن دائرة الضوء، او استمتاعاً بمراقبة الأشياء عن بعد، أو احساساً عميقاً بالتوحد. يصبح بالأحرى إدراكاً لصورة الأشياء وهي تتكون في الظل على طبيعتها الأولى. أو على الأقل كما تتراءى للشاعرة وهي تختلس النظر إليها في السر. لا يسفر الغياب، كما تعبّر عنه آمال نوار، عن الوجه الداكن للأشياء وهو ذاهب الى حتفه في العتمة. على النقيض من ذلك، إنه امتداد للنور وهو يخترق الظلال. في العادة نرى الضوء ولا نرى الظلال. النور يصعب احتجابه. من طبيعته ان يخاطب العين قبل أي شيء آخر. ومن طبيعة الظلال ان تحتجب عن النظر، لانها الصورة غير المرئية للأشياء الجامدة في أمكنتها إلى الأبد. الشاعرة، في كتابها، تعيد خلط الأوراق. تجعل من الغياب مصدراً حقيقياً للإضاءة. تسلط الضوء على ما لا ينبغي ان نراه ليصبح مصدراً للرؤية الأخرى في ما وراء الأشياء والأمكنة والأزمنة. هناك. في الصمت المطبق، تلتمع الرؤية شريطة أن يفك أسر اللغة من اغلالها لتنتفض من تحت أثقال الرتابة. تقول في نص بعنوان “عربة وهم”: (كنت على الدرب التفت نحو الخيل، لن يضلّ الوهم طريقه، في آخر الممر بيتي وحيداً بلا أقفال، ونافذتي بيضاء من حنان عيني. كنت عربة صيف كفيفة أمشي من النبع إلى البحر، وما حاجتي الى الضوء حين يجري فيّ النهر وعيني الغريقة في بطن عيني العميقة). نص نموذجي، على الأرجح، دلالة على الرؤية من موقع الغياب. فالنهر لا يجري في الخارج بل في داخل الذات. والعين هي تلك التي ترى الأشياء من بطن العين وليس من ظاهرها. لا غرابة في ذلك، ففي الغياب تنتقل الأشياء من أماكنها لتصب دفعة واحدة في الذاكرة. تختفي جميعاً لتبقى ظلالها.
الغياب حالة لا وسيلة
في أي حال، ليس في الغياب ما يشغل بال الشاعرة حيال النجاح أو التعثر في بلوغ الصور التعبيرية التي خصصت هذه النصوص من أجل ملامستها، أو الاقتراب منها، او استخدامها للوصول الى محطات أبعد على طريق الحلم الطويل. لا نلحظ شيئاً من هذا القبيل، على الأرجح. قد يُعزى السبب، في ذلك، بشكل أو بآخر، إلى ان الابتعاد المتعمد عن اللغة واشكالها التعبيرية هو جزء لا يتجزأ من “فلسفة” الصورة الشعرية لدى آمال نوار. قد يلجأ شعراء آخرون، على نحو من الحرية المطلقة في اعادة صوغ العالم، الى تقنية الغياب كوسيلة مرحلية أو انتقالية في أحسن الأحوال لمراقبة تحولات الصورة عن بعد. ثم سرعان ما يقلعون عن ذلك بعد تحقيق مأربهم. في النصوص المتضمنة في كتاب نوار، غالباً ما يسفر الغياب عن حالة عميقة من الكينونة الشعرية التي تتلبس صاحبها بالكامل. لذلك، من المستبعد، على الأغلب، اتخاذها اداة ظرفية لخدمة الهاجس الشعري ومنحه مضموناً صورياً جميلاً. اينما أمعنا النظر في النصوص، ندرك على الفور ان الغياب هو المرتفع الذي تطل منه الشاعرة ليس لرؤية الأشياء من بعد فحسب، وانما تحمله في داخلها. والأرجح انها تقيم فيه، ويقيم فيها على نحو من التشابك الدائم الذي يتعذر فك عراه. تقول في نص بعنوان: “غابة الرخام”: (وحدي على أرصفتك يا روما ثمرة نسيان… عظامك تعصف بالذاكرة، وأنا حبر يمّحي عن ذهن الشطآن. جئتك حاضنتي كي اغيب في نبيذك واتعشّق جسدك، كدعسة فرس في الريح، جئتك اقايضك وهم السنابل بدخان غجري صاعد من قبلة ظمآن…). نص نموذجي آخر عن تشظي حالة الغياب لدى الشاعرة. من غياب الى ثان إلى ثالث، على نحو لا متناه. من ثمرة النسيان الى الحبر الزائل، الى دعسة فرس في الريح إلى دخان غجري. دلالات حقيقية على أن الغياب مقيم في الروح وليس اداة تعبيرية ساذجة أو انتهازية.
من طبيعة الغياب ان تنفجر الأشياء من داخلها، ان تحدث دوياً صاخباً وهي تولد من جديد، ثم تستولد نفسها مراراً وتكراراً. ومن طبيعة الاشياء، كذلك، ان تشهد مخاضاً عنيفاً وهي تنقسم على نفسها كالولادة تماماً التي تخرج الحياة من الحياة. نلحظ، في هذا السياق، مدى اعتناء الشاعرة بهذه المسألة الحيوية. الغياب كما تراه، ليس حالة معزولة منزوية بعيداً عن تحولات الروح وتفتح الحياة على صورها المضمرة في الذاكرة الشعرية. انه في صلب الأشياء جميعاً، في نسيجها الداخلي البعيد، وفي قلب الاحتمالات التي تجعل من مكونات العالم، مادة غزيرة قابلة للتحول واعادة التشكل كلما احست الاشياء بحاجتها الى التبدل والتغير.
المفردة هي الرؤية
قد تفتح هذه النصوص الباب واسعاً أمام قضايا هامة ومعقدة حول مساهمة اللغة، بأشكالها المبتكرة، في اعادة الاعتبار الى المفردة الواحدة كمصدر حقيقي في عملية الايحاء الشعري. مسلك لا يخلو من صعوبة التجربة، يتمثل في ضبط الصورة الشعرية ولملمة شتاتها المتناثر في فضاء الذاكرة والعالم، على قاعدة مرتكزاتها اللغوية. لا تعود الرؤية الشعرية، في هذا الاطار، ضرباً من الفوضى في التخيل والتأمل واعادة صوغ الأشياء، وتشكيلها. تصبح المفردة، في هذا المنحى، ذات وزن فاعل في العبارة الشعرية. تتحول، في حقيقة الأمر، قوة جاذبة للمعنى الشعري، بدل أن تكون تفصيلاً هشاً مجيراً بالكامل لخدمة الصورة. المفردة الواحدة، كما نلحظ في معظم نصوص آمال نوار، هي رؤية شعرية، في حد ذاتها، أو جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية. تقول في نص بعنوان “في غربة الظل”: (بأي حبر ادفىء شعور الليل وبأي كلمة أصيب وتر البئر. ثمة محيطات تفصل زجاجي عن الحلم وما من جسر بين الهواء وظلي. أراني في مرآة الغياب تطفو نظرتي ويغرق بحري ولا يبان من لمستي غير الزبد، ولا من روحي غير الزيت…). نص منحوت من حجر اللغة، على الأرجح، تتعمد فيه الشاعرة ان تشتبك مع معوقات اللغة وعثراتها قبل أن تنقيها مما لا حاجة لها بها. الزيت يخرج من مسام الروح، والمحيطات تفصل الزجاج عن الحلم، والجسر يسقط بين الهواء والظل. كل من هذه المفردات ذو موقع بنيوي في النص يصعب استبداله بآخر فتتهشم الرؤية بكاملها.
ليس الغياب، في هذه النصوص، نظرية هبطت بها الكاتبة على ميدان الشعر. إنه رؤية داخلية، على الأرجح، يتوازن بها الشعر والعالم فيعيد احدهما تشكيل الآخر. لا شيء محرماً على الغياب. لا نعثر على استثناءات في هذا السياق. يد الغياب ذات دلالة سحرية بكل معنى الكلمة. لا يقوى شيء على الوقوف أمامها. قادرة على العبث بأنواع الجغرافيا قاطبة الذاتية منها والموضوعية. الغياب، في النصوص، يتجرأ على كل الأشياء، يختصر الجغرافيا. يقلصها. فينكمش العالم وتتوسع الذات. تُجبر الأمكنة والأزمنة على التقلص او التمدد أو تزول من تلقاء نفسها، لتكبر جغرافيا اللغة وتصبح بديلاً حقيقياً للعالم. يتحول العالم جزءاً من اللغة. وبالمثل، تخترع اللغة العالم، تشكله، تقتله وتحييه، تنتقل به من العدم إلى الوجود. تثبته في فضاء الذاكرة. نقرأ في نص بعنوان “العصفور الناسك”: (سأذهب الى الجبال لتتسع روحي لرعشة الأزل… أنا الأقل من خفقة عصفور والأضل من خيال ريشة والأرقّ من بصمة ضوء على المياه . سأمشي في وعر الظلال، وأُطعم النسيان بقايا عمر تفتت…) ليست الشاعرة من يذهب الى الجبال، بل ظلها، على الأغلب، فقد حررها الغياب من وطأة الجاذبية لتصبح بصمة ضوء على صفحة الماء. الغياب، في هذا النص، يصنع غيابه، يذهب الى أبعد من الظلال إلى رعشة الأزل. اللغة نفسها تصبح ضرباً من الغياب. اللغة هي الغياب.
(2)
آمال نوّار شاعرة الحدس تخترق متاهات «الأنا»
(الشاعرة اللبنانية المغتربة في ديوان جديد)
عابد إسماعيل (سوريا)
جريدة الحياة - 08/05/2008
تبرز الأنا كمنبع للرؤيا في قصيدة الشاعرة اللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية أمال نوار، وأساس تبني عليه نظرتها الى الوجود، فمنها تتناسل الصور، وتتدفّق الدلالات، وتتشكل الرموز. وهي بذلك تعتمد أحادية الكلام، الخالي من التعدّدية الصوتية، الصادر عن متكلّم واحد وحيد، يعبّر عن عالمه الداخلي بأكثر المفردات توحّداً وانزواءً. والشاعرة تلجأ الى المناجاة الذاتية لترجمة مكنون وجدها، لأنها تخشى الإفصاح للآخر، أو حتى المغالاة في التعبير، لئلا ينكشف سرّها، وتجرح المعاني كبرياء انكسارها. وعلى هذا الأساس، تقترب في ذاتيتها من عتبات الرؤيا الصوفية، التي تسمح بالغوص عميقاً في متاهات الأنا، وهتك الحجب المضمرة للدلالة، والاقتراب من جوهر المكابدة الأنثوية، بالاتكاء على بداهة الحدس، وندرة الإشراق الروحي، وقدرة العبارة على الإيحاء والتكثيف.
في ديوانها «نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج» الصادر حديثاً عن دار النهضة في بيروت، تحدّد الشاعرة طبوغرافيا خلوتها، وتختار عزلتها موضوعاً مركزياً لقصائدها، كاشفة منذ البداية، عن روح مكلومة، تقيم في أقصى الظلّ، بعيداً من ضرورات العالم ورغباته المزيفة. ففي قصيدتها الأولى «في غربة الظل»، تسحبنا الشاعرة إلى جحيمها الصغيرة، وتفاجئنا بتلك الكآبة الصامتة التي ترصّع كل عبارة من عباراتها. هذه الكآبة مردّها شعور مبطن بالخيبة، ووعي متقدّم بفقدان الطمأنينة، في عالم يزداد قسوة وعنفاً. ونوار تجيد حقاً اصطياد لحظات الخسارة تلك، من دون ضجيج أو مبالغة، تسعفها رغبة واضحة في مسرحة تناقضات الأنا، ورصد انشطارها في مرآة الغياب: «أراني في مرآة الغياب/ تطفو نظرتي ويغرق بحري/ ولا يبان من لمستي غير الزبد». وتقابل سينوغرافيا الألم هذه مسرحة لهباء الكينونة أو زبدها، وإدراك عميق لمأزق الأنا في العالم، عبر احتمال اعتلال الجسد، وفقدانه الرغبة في الوجود، فالحجر، حتى الحجر، «يشعّ بعماء سرّه»، والعالم، الذي ندركه بحواسنا الخمس، ما يفتأ يتحرك ويتبدّل ويتغيّر من حولنا: «الجسد أيضاً يدور،/ ولا تشعرُ به الأرض». هذا الأسى الشفيف تكابده الشاعرة بقلبها أولاً، ثمّ تترجمه خفقاناً متواصلاً في اللغة، ففي كل جملة نلمح طيفاً يهبط ويشيعُ ذبولاً في أرض الكلام: «على كتفيّ ستحني شجرةٌ ذبولها/ ولن يرتعد فيّ أي طير».
وبطلة القصائد أنثى متوحّدة ترتدي قناع الفراق، وتعاني هجراً متواصلاً، متأمّلة المسافة التي تفصلها عن الآخر، فنراها تدعو نصفها الغائب إلى أن يقرأ في كتاب جسدها، ويفكّك أبجديته الغامضة، ويفسّر لها أحلاماً جليديةً لا يشعّ منها سوى الفقدان: «ابتعدْ كي ترى كيف وأنا أنام/ يسودّ الكلام على جلدي/ وكيف أحلامي/ تتدلّى في الأفق كالجليد من النوافذ». وحين يتحول جسدُ الأنثى إلى نصّ، ويدخل في متاهة التناصّ، يسترجعُ تاريخَ قمعه كلّه، نابشاً هواجس متأصّلة، كتلك التي تكشف عنها الشاعرة الإغريقية سافو في قصائدها العشقية. فخطاب العشق محكوم بذاكرة أسطورية، كما يشير رولان بارت في كتابه «مقاطع من خطاب عاشق»، وهي ذاكرة تبوح أو تدلّ بالنيابة عن الأنا أو الموضوع، وتدوّن، بالتالي، تاريخاً جمعياً ثاوياً، يضع الأنثى وجهاً لوجه أمام تاريخ أنوثتها. هذا ما تلمّح إليه نوار، حين ترى الأزل لحظة سديمية، يخترق الحاضر، ويكثّف الزّمن في نظرة واحدة: «لا لونَ للأزل إذ يبرقُ من نظرتي/ وأنا أخترقُ بصمتي الجماد». هذا الأزل السديمي يذكّرنا بمفهوم إميلي ديكنسون للزّمن، وكيف أنّ برهة خاطفة قد تكون كافية لهتك حجب الأبدية بأسرها.
هذه الرغبة في الكشف تصل ذروتها حين تستعير نوار أبجدية الوجد الصوفي، مركّزة على علاقة النفي المتبادل بين العاشقين. فالحب لا يقيم إلاّ في الهجر، ولا يتحقّق إلاّ في التواري والقطيعة: «يا أنتَ/ يا روح التراب في الظلّ/ إرادتي صداع الصخر/ فتّتْني حجارةً في لمستكَ/ وذرّ أحاسيسي في تراتيل خطاك». إن الرغبة في الذوبان في الآخر، لا تعني التخلّي عن الأنا، والتضحية بمركز كينونتها، عبر ما يسمّيه رامبو «تشويش الحواس»، بل تهدف إلى تحرير الروح الشعرية من رقابة العقل، وإطلاق المخيلة من عقالها، والكشف عن المكبوت والمنسي في اللغة والجسد معاً. فالشاعرة تدعو إلى «ذرّ أحاسيسها» في فضاء الآخر، أملاً بالانعتاق من أسر الضرورة الذكورية، والفرار من التاريخ البطريركي للرغبة. ومها يكن من أمر، فإن الرؤيا الصوفية هنا تنشد التحرر من ربقة اليقين السائد، والانطلاق خارج أنقاض الحواس، لعلّ الحقيقة العليا تشفّ، ويصبح الإنسيّ سماوياً والسماويّ إنسياً. وتركز نوار على هذا التجاور بين الأضداد، والذي يعقبه صحو روحي نادر، حيث تحلّق الروح العاشقة في فضاء الوجد، وتضيق المسافة بين الأنا والآخر: «وأرى ملاكاً من ريش بين أصابعنا/ يضمّ الخرائط بجناح/ والزّمنَ بجناح/ ليضيّق الفضاء بيننا». هذا البوح يسعى إلى تقريب المسافة بين الوهم والواقع، وإن كان ينزع صوفياً إلى تأبيد الحلم، وتمجيد طاقة اللغة على الكشف عن الجوهر السديمي للحقيقة: «لكأنّي كلّما شفّ زجاجي/ تعتّق فيّ الوهم». هكذا، وفي تمجيدها للوهم، تذهب نوار إلى أبعد نقطة في غربة الذات، مشيرةً إلى أن حوار الرّوح والجسد يجب أن يقوم على ذوبان الأنا في الآخر، وربما نفي الأنا للآخر: «ما كنتُ له سوى وهم/ يربّيني في جلده/ كمن يربّي فأساً في جذعه». ويتكرّر رمز الفأس في أكثر من قصيدة، للتدليل على قسوة الهجر، فالرّوح العاشقة تبري الجسد مثلما تبري فأسٌ جذعاً. وإذا أراد الحبّ أن يبقى، عليه أن يعي حلوله في النقيض، وتحقّقه الأبدي في الفراق والحرمان.
صراع الاضداد
لكنّ الشاعرة تدرك جيداً أنّ الغبطة زائلة، وأنّ التناغم حلم صعب المنال، فالكائن مفطور على التناقض، ويتحدّد وعيه من خلال إدراكه الصراع القائم بين الأضداد، كما يعبر وليام بتلر ييتس، في كتابه العرفاني الشهير (رؤيا). ونوّار تستعير روح هذا الصراع، وتفعّله بمهارة في خطابها الشعري، مضيفةً لمسة صوفية مضمرة إلى صيغتها الفنية، ليجد المعنى ضالّته دائماً في النفي وليس الإثبات. ونوّار تحتفل بالنفي، الذي ترى فيه علّة وجود الأنا: «فأنا جمرٌ معصوبٌ بالغيب/ ومثل البحر/ أبتلع شمساً،/ فأظلمُ». إنّ الجمر يعرف كيف يخفي نقيضه - الرّماد، والضوء يعرف كيف يتكتّم على سرّه - الظلام. هذه، بلا شك، ومضات صوفية عالية، تحيل القارئ إلى بعض مواقف النفّري في مخاطباته، وإلى الرّمزية الغنوصية عموماً التي ابتدعها شعراء التصوف كالحلاّج وابن عربي ورابعة العدوية، وسواهم. بيد أن نوّار تتجنّب البعد الفكري أو الفقهي في هذا النظام، وتكتفي بوصف لحظات الانخطاف أو الإشراق، في تلك الجدلية المرآوية بين الأنا والهو، حيث تكمل الأنا الآخر وتنفيه في آن واحد: «إن ترني بقلبكَ ترني بعيني/ كأنّك منّي الجهر وأنا الخفاء/ كأنّك أنا وأنا ظلّي». هذا الديالكتيك بين الجهر والخفاء، أو الأنا وظلّها، لا يترك أثراً ليقين شعري، ويجعل المعنى يتفتّت عند عتبة الكشف الصوفي، حيث اللغة تكشف حالة رفيعة من المكابدة الروحية، تعبر عن نفسها في حوار الظل والضوء، أو السرّ والحقيقة. والشاعرة تدرك بحدسها استحالة الكشف عن سرّ، فتتمسّك بالحيرة، التي هي سمة كلّ بوح صوفي، فالعاشق يقترب في بعده، ويصمتُ في بوحه، وربّما يخون في وفائه: «سرّي لا يُسرّ إلى أحد/ ... خيانتي لا تخونُ أحداً». هذه الوقفة تتكرر في القصيدة الختامية، الأكثر نزوعاً للرؤيا الصوفية، المسمّاة «عمياء الحلم»، حيث تصل درجة المكاشفة/الصّمت بين العاشقين ذروتها، بل إنها تشارف حدود النفي أو الموت: «لا أرى سواه/ هو الذي لا يراني/ وأنا أبصرني أراه/ حتى أكاد أعميه/ وأعتلّ حتى أمسي شبحَه». إنها حقاً ذروة الانمحاء في الآخر، متحقّقة هنا عبر استبدال المعنى بنقيضه، فالجسد يعتلّ متحولاً شبحاً للآخر، والعتمة تشفّ متحولةً ضوءاً، كما أن الحدس الشعري يشفّ متحولاً رؤيا تتّسع وتمتدّ.
لكن، وعلى رغم هذا الافتتان بالوقفة الصوفية، رؤيوياً على الأقل، لا تخفي قصيدة نوّار أنها تنتمي أسلوبياً إلى مدرسة الفن من أجل الفن، التي كان روّج لها أوسكار وايلد وإدغار بو في القرن التاسع عشر، وشدد عليها شعراء الحداثة الأولى في الشعر العربي الحديث، مثل أنسي الحاج وأدونيس. فالشاعرة تكشف في ديوانها عن حساسية تحتفل وتمجّد غائية القول الشعري، الذي لا وظيفة له خارج تخوم عالمه الخاصّ، البعيد من التبشير أو الوعظ، فالنص يحمل قيمته في ذاته، وهذا ما يسمّيه نقاد الحداثة اليوم «الأدب المطلق»، الذي يجب أن يُعنى بجماليات خطابه بالدرجة الأولى. والشاعرة نوّار تغيّب تلقائياً الوظيفة المباشرة أو التداولية للغة الشعرية، وتركّز على طاقة الإيحاء الكامنة فيها، عبر تمسّكها بقيم الاسترسال والتداعي الحرّ. هذا الإخلاص لغائية الفنّ يتطلّب دربة جمالية عالية، قادرة على احترام مبدأ التضاد، والمكوث طويلاً في التناقض، من دون أن تفقد الأنا الشعرية رهافتها أو وهم وحدتها.
(3)
آمال نوار: خمرتها صافية وثوبها يعكس الخرير
حسين بن حمزة (سوريا - لبنان) الأخبار - 6/ تموز/ 2007
جملة متينة وثراء معجمي واستعارات مستجدّة. هذه هي أكثر الصفات التي يلمسها قارئ مجموعة «نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج» (دار النهضة) للشاعرة اللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة، أمال نوار.
يستطيع القارئ أن يُشهر كتابة أمال نوار في وجه كتابات كثيرة مكتفية بعوالم شحيحة، ويوميات عادية، وشؤون مفرطة في شخصانيتها. المجموعة الثانية لنوار ليست بلا شؤون شخصية، ولكنْ ثمة أعماق ومعالم غائرة في قصائدها، وهذا ما يعطي انطباعاً فورياً بدسامتها وكثافتها، حتى إننا نجد كثافة متراصّة في الجملة الواحدة أحياناً. النتيجة أن الشاعرة تكتب قصيدة ذات طبقات عدة ومعانٍ ومقاصد شعرية كثيرة. ثمة تفكّر شعري ومكابدة، مهارات واقتراحات، في هذا النوع من الكتابة. إنها كتابة تمزج بين تلقائية الألم الذاتي، والتقنيات الأسلوبية التي تصنع لهذا الألم نبرته وتجلياته المختلفة ولعل الألم، وإن لم يتكرر بالمفردة عينها في كل مرة، هو القاسم المشترك للتجربة التي تنهض عليها معظم قصائد الكتاب. ثمة وحشة وعزلة وانتظار وندم وافتقاد. لكن أمال نوار تعمل طوال الوقت على دفن هذه المعاني تحت الكلمات والصور وفي طياتها. أما القارئ فيتلقى ضربات الوحشة والافتقاد من أحشاء القصائد، حيث الآلام مدفونة ولا يصل أنينها إلا مكتوماً.
الأرجح أن هذا الوصف يصلح لتتبع المواد والمذاقات والروائح الأولية التي تتدخل في صياغة قصائد الكتاب. وعلى القارئ أن يعثر عليها، وقد تحولت إلى شعر خالص. عندها يمكن أن يختبر ويتذوق جملة مثل: «بعيدةٌ المراكب عن ذهن المياه»، أو «يدي تزرقُّ في يدك / من دون لمس».
سعيُ أمال نوار إلى كتابة مكثفة هو إحدى خصال نبرتها. ولكن الكثافة لا تقيّدها بشروطها التقليدية الدارجة، ولا تجبرها على إنجاز قصائد قصيرة ومقتضبة. إنها تخوض مغامرة شديدة الخطورة، حين تستطرد وتسترسل بمواد مكثفة. الأرجح أن جعل القصيدة تحلّق بجناحي الكثافة والاسترسال معاً، يفاقم الجهد الشعري المبذول في كتابة القصيدة. غالباً ما تبدأ أمال نوار قصيدتها باستهلال يفتح أمام القارئ ــــ وأمامها هي أيضاً ــــ مسلكاً وعراً لإتمام العمل. إنها تبدأ من مفتتح يعدها بممارسات شاقة ومنهكة، للوصول إلى خاتمة القصيدة. متعة الكتابة موجودة في هذه الرحلة ذات الكلفة الوجدانية والنفسية والشعرية الباهظة. ما يخفّف من وقع هذه الكلفة، هو أن الشاعرة تصنع حساسيتها ونبرتها بها. ثمة أمثلة كثيرة تشير إلى أن أمال نوار تستعذب الممارسات الشاقة في كتابتها. المدهش في الأمر أنها تنجح في جعل ما هو شاق، جزءاً من جودة القصيدة وتميّزها. هكذا نتلذذ يقراءة شاعرة «لا يهم / أمِنْ عشبٍ جسدها / أم من جليد / ما دامت مياهها صافية / وثوبها يعكس الخرير».
(4)
بـــــوح مــــن أبـــــواب خلفـيــــــة (”نبيذها أزرق ويُؤنس الزجاج” مجموعة آمال نوار الشعرية)
عناية جابر(لبنان)
السفير 24/07/2007
لقي «تاج على الحافة» (دار الفارابي 2004) الإصدار الأول للشاعرة اللبنانية امال نوار (تعيش في اميركا) استقبالا نقديا طيبا، وصدر لها حديثا عن «دار النهضة العربية» جديدها الشعري: «نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج» حيث اللغة العالية والمتينة، تعيد تركيب عالم الكاتبة، تسنده وتغني موته.
اللغة عند نوار، تلعب وجود الكاتبة (الخارجي) الصامت والفارغ والمهزوم، وهي في الوقت نفسه، لا تتوقف عن تأسيس عالم بديل، داخلي ويضطرم بمكابدة أليمة، وبرغبة الحب والاتصال بالاخر، شعوريا وجسديا. لغة على ثرائها تبتعد كل البعد عن ان تكون صوفية، او متأملة، بل هي في خدمة الوصال، ايروتيكية في مواضع وان ترقق هذه الايروتيكية العبارات المنغلقة على نعوتها الطرية.
الصعوبة الحقيقية بعد، او اثناء قراءة «نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج» هي لهاث القارئ خلف الترميز، وخلف الحدسي والعاطفي المحتضن باللغة «الفخيمة» ولكن الجمالية بالضرورة، والموظفة كما شاءتها الشاعرة، في خدمة الغموض، وعدم المباشرة، والاستعارات التي تقارب بوح الشاعرة المتقد، ولكن من ابواب خلفية غير ميسرة على القارئ العادي.
انشطار داخلي
في مجموعة نوار الثانية هذه والجديدة، تذهب الشاعرة شوطا بعيدا في الشعر متسلحة بلغتها الأنيقة واستعاراتها المستلة من عربية لا تتنازل لخدمة اليومي والتفاصيل. قصيدتها تتخلى في مناخاتها واسلوبيتها عن “الدارج” في الشعرية الجديدة وفي طريقة التناول والنظر الى الاشياء. قصائد تعيش بالايحاء، بالحلم، بالرغبة، بالتخييل والمحاكاة الانسانية وبالالفة الغريبة مع النقصان والاستحالة، كما لو من النقصان والاستحالة تبني نوار عوالمها الشعرية، وفي هذا منتهى مكابدة قصيدتها ومنتهى جمالها.
تقول نوار:
“ليس سواك من تشهق به رمال الجسد، من تتفاقم غفواته على موجي، تنام فيّ وأنام فيك حتى يلامس غصنك غصني، بحفيفنا نمخر زبد الظلمات الى ان تغيب فينا الارض.” (ص 54)
الرؤية الشعرية عند نوار ليست في كتابة انشطار ذاتها عن العالم فحسب، ولكن في كتابة انشطارها الداخلي نفسه، ووحدتها المقيمة كغصّة دائمة، تبين على شكل قصائد/ مونولوغات، هي صورة هذه الرغبة الى وصال مستحيل وتحكمها الوحدة المستفحلة. ايضا، المخيلة الشعرية لدى نوار وجه لرؤيا صراعية بينها وبين العالم الصامت حولها، والبعيد، وتدور في رغبة ووله دراميين عاصفين في القصيدة، وفي شرطها الانساني والفني وصياغتهما. ثم ان الشاعرة التي تعاني غربة قاسية وترقد في برد الخارج، ترى في قصيدتها الى دفء رغباتها والى الكلف والتوله والغرام الاقصى بلغة مكثفة ومقطرة حدّ التعالي احيانا، هي الحلقة الوصل بين واقعها وبين أناها الرافضة لهذا الواقع، والمشبّعة بمخيلة دفء الحب والارتماء في الاخر حتى الذوبان.
“جاءني طير في المنام ينقر وردتي تلسعه الأشواك بملحها فيتخدّر فيه القصب جاءني يدوزن عيدان المطر ويحيل رخامي الى شمعة في دغشة لا يُسبَر في بئرها شرود الغزلان. (من أهزوجة خادمة في منام الجسد)
في قصائد نوار، الاسلوبية الدامغة التي ترفع صرخات الداخل، غنيا ومترفا وقويا خلف كل ما يعتريه من قهر وألم.
ورم الوحدة
هناك اصوات عديدة في اسلوبية الشاعرة، تتحدث في القصيدة من دون ان تتقاطع، وتعرف كيف تنأى بنفسها عن الثرثرة، وتعرف فن الاصغاء للعالم الداخلي وللعالم الخارجي، خصوصا الاصغاء لجسدها برغباته المؤثرة.
تميل نوار الى الافساح لقصيدتها بتوكيد حضورها، عبر تسخير لغة بالغة الاناقة، وببالغ الرهافة الكتابية، لدرجة ميل القصيدة الى نوع من الايقونية، البعيدة عن مكابدات الغرام العادية، او الغرام باللحم الحي.
مع ذلك، باستطاعة قصيدة نوار، وعبر اللغة المعتنى بها، إقامة حفلها الخاص، الذي يعدّ اختياراً للشاعرة ويحسب عليها، بعيدا من حداثيات شعرية متداولة الان، ولا تخلو من قوة وتأثير.
الوعي عند الشاعرة امال نوار، هو الحلم، وهو الصور التي يستدعيها هذا الحلم، فلا تهتم قصيدتها بالمباشرة والتلقائية او اي نوع من انواع العفوية، او تسمية الاشياء بأسمائها. هو اختيار الشاعرة اذن، ورؤيتها الى النهوض بقصيدتها عبر موروث لغوي جميل، وعبر تطويع المفردات لصالح محاكاتها ورم الوحدة البالغ، وعذوبة الشعر.
(5)
تـربـيــة الفـأس فـي الـجــذع
“نــبيذها أزرق ويـؤنـس الزجـاج” لأمـال نـوّار
زينب عسّاف (لبنان) النهار 25 تموز 2007
الرومنطيقية التي يمكننا إدراج المجموعة الثانية لأمال نوّار في خانتها، هي رومنطيقية من طبيعة الشفرة. وإذا “سايرنا” عنوان المجموعة، “نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج”، الصادرة حديثاً لدى “دار النهضة العربية”، لقلنا: من طبيعة الزجاج. لا نقصد أنها رومنطيقية مسلّحة بالطبع، بل رومنطيقية جارحة. ففي هذا الديوان الجميل ثمة جروح وندوب وآثار. جروح تقرّر المسافة بين طرفَي الجملة وطرفَي الصورة وطرفَي المعنى. قصائد هذا الكتاب أشبه بتربية الفأس في الجذع. تتكسّر قصيدة أمال نوّار على مرأى الزجاج ومسمعه. تتكسّر وتجرح. كسور أنثوية تقيس العمر بالأجنحة، ولا ترى نهاية لأصابعها حين تلمس الزجاج. هذا الزجاج الطيّع في تكسّره، لا يلبث أن يعيد تشكّله، معيداً تعريف نفسه وتعريف الشاعرة من خلال ذلك. تقول أمال نوّار: “ومشيتُ على زجاجك كالخدر”. نحن هنا إذاً أمام زجاج ينطوي على إحالة: الماء. وتالياً، هذا الزجاج - الماء لا بدّ من أن يحيل الماشي عليه مسيحاً آخر. مسيحاً أنثى؟ ليس لدينا ههنا من دليل أفضل من الإشارة إلى كثرة استخدام فعل “شفّ” ومشتقاته في سطور هذا الديوان.
يضفي هذا “التكرار” الذي يصحّ وصفه بالعضوي، متعة إضافية من خلال البحث عن تصاعدية افتراضية بين استعمال وآخر، وصورة وأختها. وكمثال على ذلك نستلّ الآتي من صفحات مختلفة من الديوان: “ذهن الماء” (ص23)، “ذهن خريطة” (ص51)، “ذهن الجِرار” (ص64). فكما نرى إن المضاف إليه المتغيّر هنا هو الذي يمنح لفظة (صورةَ؟) “ذهن” أفقها الشعري. وفي حين يمكننا الزعم أن ما يربط بين “ذهن الماء” و”ذهن خريطة” هو السطح والتسطيح في معناه التضاريسيّ، يمكننا الاستنتاج أيضاً أن ما فعله التكرار الثالث (”ذهن الجرار”) هو نفي هذين السطح والتسطيح لمصلحة الباطن، من حيث أن الجرار “تبطن” الماء، ومن حيث أن خريطة الجرّة باطنها. نحن نلعب طبعاً، لكن تحت سقف “فتوى” شهيرة لرولان بارت تؤكّد أن سياق المعنى يأتي من النقد لا من النصّ. في قصيدة عنوانها “في حبر النوم” تقول الشاعرة: “هناك، في العمق البلّوري لصدركَ/ أرقد/ لغةً قديمة في عصور النوم./ هناك، حيث الفخّار يمزّق قلبه/ ليظلّ جنينَ النار،/ وحيث حجر البحر يتّقد بحجر السماء/ كلّما تشظّى في ضلوعك موجٌ/ دوّت في مناماتي جرار…”.
الزرقة، الجذع، الزجاج، الجرار… مفردات تتكرّر لتشكّل علامة فارقة في معجم أمال نوّار الشعري. اللغة الشفيفة التي تندلع بها سطور الشاعرة هي لغة تنمو، في معنى عدم انشطاريتها. لغة تكبر ولا تكثر. أيضاً هي لغة - كالأرض - تدور ولا يشعر بها القارئ. ثمة مطبّات نثرية بالتأكيد، وخصوصاً حين يزداد منسوب المشاعر التي يُراد البوح بها، مشاعر امرأة تعاني - سوى الوجود - يومياتٍ تصطنعها هويتها كأنثى. هذه النثريات التي نقع عليها هنا وهناك في كتاب نوّار، تعطي الشعر مساحة أكبر مما هو مخصص له، مساحة إضافية للعادي والبسيط والبخس. فلنقل إن أمال نوّار تحاول تذويب جليد يومياتها في موقد الشعر، وتحاول تسييل هذه اليوميات بحرارة اللحظة الشعرية. في هذا الصدد يمكننا أن نتلمّس الإحساس الدائم بالضآلة لدى الشاعرة: “عمري كلّه بثقل مَطْرة” (ص27)، أو قولها: “أنا الأقلّ من خفقة عصفور” (ص60)، حتى أننا إذا عدنا إلى ديوانها الأول “تاج على الحافة” (دار الفارابي 2004) قرأنا مطلع قصيدة “كينونة الصفر”: “سأقبع في حجمي الطبيعي: اللاشيء”. هذا الإحساس “الأنثوي” بالضآلة هو إحساس بالخسارة أيضاً. إحساس بوطأة الوهم في عالم لاشعريّ، وبعجز الحلم أمام “فحولة” الواقع: “في الليل يُشمس قلبي وتخضرّ أحاسيسي/ في الليل أسمع حفيف شجرة تحت عشبي الحزين؛/ شجرة باتت عظامُها قصباً لشهوة الريح./ هنا، حيث كرسيّ وجدار/ تحفر الكلماتُ الجذع،/ هنا حيث الفأس والمزمار خريفان بعنق واحد،/ وحيث القشّ يتطاير من يباس صوتي”.
بطانة الجسد
وراء جملة أمال نوّار أنين ومنام، وبكلمة واحدة هناك هذيان. كلام يقوله النائم بقدرة اليقظة، ومنام مزهر بالحواس والرغبة المرمية في قفص. لذلك في وسعنا القول إن الجسد في قصائد الديوان هو لغة خلفية وصورة خلفية، بمعنى آخر هو بطانة هذا الديوان، أو جرح مخفيّ منزوٍ يمارس سحر احتجابه على المعاني. التبطين هنا ينال من العبارات أيضاً، فتبدو اللغة كثيفة متدرّجة ممتلكة حنجرة بطبقات متعددة من الأصوات. هكذا، يمكننا تتبّع الأبيات عمودياً في معنى الحفر، كما يمكننا السير خلفها أفقياً في معنى الانسياب والإتاحة. في بحثنا عن أمكنة يغطّ عليها الكلام، نجد أن الشاعرة تعيش وتكتب في مكانها الداخلي غالباً متناسيةً المكان الواقعي، إلا في حالة واحدة هي حالة تطابق المكانين معاً، كما في قصيدتها “غابة الرخام”، التي تناجي فيها مدينة روما وتسمّيها “حاضنتي”. هذه القصيدة التي تشبه فعل الحب والذوبان، تحمل حاجة قوية لدى الشاعرة إلى التماثل، إلى التمرّي على رخام الزمن، “ما من حجر فيك/ لم تسوّد روحه بدم الدهر”، وصولاً إلى اكتمال الأوتوبورتريه وامّحاء الحدود بين الجسد والمكان، أو الاختلاط الكامل بين غابة الشعر وغابة الرخام: “جئتك أتلوّى بين المناديل/ من أصابع قدميّ حتى قرميد قلبك”. في هذا المعنى، تبدو هذه المدينة - التوأم مكاناً أصلياً وحيداً، وما عداها من أمكنة هي صور بالأبيض والأسود، صور غير متحرّكة، في معنى عدم قابليتها للتأثير على الكلمات: “نسكن أماكن لا تسكننا/ نتنفّس هواء لا ذكرى له ترفّ/ في يباسنا”.
يمكننا القول إن امال نوّار تقوم بدور الكيميائي أيضاً في هذا الديوان، من حيث إجادتها خلط العناصر المختلفة من هواء وماء ورمال وحجار، لتستخرج من ذلك كله لغة هي بنت الطبيعة، لغة رومنطيقية في الضرورة إذا أردنا اتّباع المصطلحات، لكن في المعنى الذي أشرت إليه سابقاً. لأن لغة الشاعرة هي ابنة طبيعة معادة التشكيل، طبيعة يمكن وصفها بالاصطناعية مع قليل من التطرّف. إعادة تشكيل الطبيعة تتمّ من خلال تقريبها، من خلال تسهيل مزجها بالنفس الآدمية، وبناء على ذلك، لا يعود مستغرباً ذاك الخلط المقصود والجميل الذي تمارسه الشاعرة في أكثر من مكان، كما في: “لا أثر للغاب على جلدي”، أو “أنت المجروح من كبرياء أفق”، أو حين تصف قلبها بالقول “من يهيم كغيمة/ ليس من يجفف عينها”.
سماء تحطّ - طير يعجز
ثمة لدى الشاعرة توق إلى المساحات الشاسعة يبدو مشابهاً لتوقها إلى الشفافية والارتقاء. في عبارة أخرى ثمة حاجة قصوى إلى توسيع دائرة الرؤية تتمظهر في حركتين إحداهما أفقية والأخرى عمودية، وتجد ترجمتها اللغوية في تكرار كلمات تشبه تعاويذ استدعاء الحلم أو إشارات مرور لخيال جامح تحتاج إليه الشاعرة في واقع يابس وعنيد: “هي السماء تحطّ على كتفك/ حين يعجز فيك الطير”. أمال نوّار تلوذ بالقصيدة إذاً، تفتح زجاج القلب حين تظنّ أنها تكسره. في ديوانها الثاني لا يضلّ الوهم طريقه، ولا الشعر. قصائد “كأنها آية رمل في كتاب الريح/ ولا يزيدها الضوء إلا امّحاءً”، على ما تقول الشاعرة نفسها.
(6)
الشاعرة اللبنانية أمال نوّار “كمرآة في ذهنها فحوى الحواس”
نصر جميل شعث (غزة – فلسطين)
جريدة إيلاف – 18 سبتمر 2007
بعيدًا عن الطوفان اليومي للنصوص والمجاميع الشعرية المكتوبة على إيقاع التساهل وسهولة النشر، وعلى وقع المقالات الصحفية المشاركة في تطبيع هول الرداءة؛ لعدم وعي الذهن بمبدأ المرآة، ولعدم التفريق بين الشعر وتفاصيل السطح التي قوّضت العبارةَ والهيبة في القصيدة؛ وبعيدًا عن تواطؤ النظرة المكبوتة مع بدعة الاستعراض الإيروتيكي المكتوبة، وما إلى هنالك من أضواء فجّة يَخجل منها مثالُ الضوء، ويخجل منها مُواطِنُ الظلّ .. بعيدًا عن كل ذلك، وقريبا من الذات في الظلّ الخلاق؛ تعود مواطنة الشعر، الشاعرة اللبنانية أمال نوّار (المقيمة في أمريكا)، لتقدّم للمشهد الشعري العربي مجموعتها الشعرية الثانية الموسومة بعنوان: ” نبيذها أزرق ويُؤنِسُ الزجاج”، (دار النهضة العربية، تموز 2007). وذلك بعد أن أصدرت مجموعتها الأولى بعنوان: ” تاج على الحافة” (دار الفارابي، 2004 ). حيث نرى مهارة أمال نوّار الشعرية، خلال أنشطةِ الحواس والشعور المتلاحقة؛ على أنّ ما تتميز به قصائد نوّار هو التؤدة، وامتلاكها قاموسًا من المفردات والتراكيب والاستعارات والصور الفريدة واللدنة المنحازة للرمل والحجر والصلصال، والموازنة بين الرومانسية والايروتيكية. بجماليات الانحياز والتوازن، هذه، تحتفظ، الشاعرة، بخصوصيتها التي تميّزها عمن حولها من “اللبوات” أو ” اللمْبات” الإعلامية المبذولة في فضاء الورق والانترنت. وهو ما كانت عبّرت عنه نوّار في أكثر من قصيدة، عن إيثار ذاتها الشرود إلى “الداخل”، والإقامة في “الظلّ”، فكلاهما مَعيْن وسَماء الموهبة. ولنستشهد، مثلا، بقصيدة “عربة وهم”، والتي فيها تقول نوّار:
“ما حاجتي إلى الضوء حين يَجري فيّ النهر وعيني الغريقة في بطن عيني العميقة؟ ذلك أنني كنتُ دنيا أضوءُ وأحلكُ أمشي وأنا شاردة خلف الباب”.
نوّار في غربة الظل:
إذن، تبتدىء الشاعرة نوّار مجموعتها الجديدة بقصيدةٍ تحمل عنوان: “في غربة الظل”. وما بين عنوان المجموعة وعنوان القصيدة الأولى نَلحظ - عشية المضيّ في عالم الشاعرة- البنية الدلالية العامة للمجموعة، خلال هذا التقابل بين “غربة” كوضع وموضوع وجودي، وفعل المضارع “يُؤنِسُ”. وكذلك بين “الظلّ” كغموض وإيحاء، و”الزجاج” كشفافيةٍ بوصفه بيانـًا للون نبيذِ الشاربة الشاردة الغائبة، التي يَعْبر بها النبيذ الأزرق غاية الوصال؛ إذا ما علمنا أنه المبتدأ والفاعل، معًا، في عنوان المجموعة. ولكنه يؤنسُ الزجاجَ من الداخل. وهكذا، يؤهلنا وصفُ ما تقدم لقراءة نوّار في غربة الظلّ. فمنذ تلك القصيدة الأولى تراوح الشاعرة كتابة حَرَجها وحيرة إجابتها أمام برودة الليل وفراغ البئر، أي أمام سؤال النار وسؤال الماء. فتتساءل:
” بأي حبر أدفىء شعور الليل وبأي كلمة أصيب وتر البئر؟”
وتظهر حقيقة انفصال الزجاج عن الحلم عندما يُصاب الزجاج بالمؤثرات الخارجية، فيعيق ذلك وصالَ الرؤيةِ الحلمَ أو الرؤيا. لذا تعبيرًا عن خطورة الوضع الخارجي ترسم الشاعرة لها جسرًا، في الأفق، بين الهواء(القلق) وظلها(الوهم).. والنتيجة أنها ترى ذاتها في مرآة الغياب. ونرى، بدورنا، ” امرأة الثلج” في مرآة الحضور، تكتب عنها امرأة ثالثة، بلغة حياد إيجابي، طالبة من الرائي النظر بظاهر العين وبطنها إلى الوضع والحال:
” أنظر إليها في الصقيع كيف هي منغلقة على ذاتها”.
ولكن حالة الانغلاق، هذه، والتي تستند إليها شعرية المجموعة؛ لا تؤخذ بالمعنى الذي يعلّله علم النفس، بل بالمعنى الذاتي المنفتح على فلسفة الاتجاه للداخل. ذلك أنّ الأرض باردة، مثلما تصرخ الشاعرة بذلك، في قصيدة ” شجرة أول الليل، وآخر البحر” ، قائلة:
” أنت باردة أيتها الأرض باردة حتى ولو اشتعل زيت بحارك في دم الحجر”.
وعليه، فقصائد الشاعرة هي وصال روحي، بطاقة إيروتيكية متحولة في العمق. فلا يَصعد الجسدِ لسطح لغة الاستعراض، ولا تظهر رموز الاتصال العضوي. وإنما هي طاقة صادرة عن نشوة، وعن حلم يسري في جسد الأنثى/ الكتابة؛ منشدًا لحظة الإفاضة العظيمة على برودة الأرض القاصرة عن التمرئي في مرآة الصفاء الذهني الصادر عَن ـ والمنعكس على ـ والخالق لـ ـ نشوة الحواس وجموحها وتماوجها وتمازجها في هدأة زرقة النبيذ المرئي كبيان كابٍ، للرائي، من خارج الزجاج. لذا، بقدر ما تبحر العبارة الشعرية في تحولات الإستعارات والصور، للتعبير عن شهوة الجسد وحرارة الداخل، بقدر ما تشتهي الشاعرة الغموض كمتعة وكشكل من أشكال الوصال والحلول في العتمة والظلّ بوصفهما مَعْقلي الحنان والحنين السرّيين:
“إذ غير متاع الظلمة /ما الذي يؤخذ إلى أحشاء البحر؟”
وهي بهذة الزرقة المظلمة ليست متشائمة، من الداخل، ولا قصيدتها مثقلة بالتراكيب المأساوية المدفوعة، بوقع الخارج مباشرة عليها، وإنما هي عاشقة وصال وحالمة. فهي ذي تقول:
“بلؤلؤ أعمى لفرط أسراري أشتهي وصال كلماتك”؟!
وهذا التكتم الداخلي على وصال الكلمات/الشعر بمكنون الأنوثة، إن هو إلا مواصلة نوّار إعلاءَ غنائية الظلّ، في الوقت الذي تصل الآخر المطلق بالمخاطبة، وتجهر للقارىء بالشعر الجميل، حتى غدا الجهر أناها، وهي ظلها، في قصيدة ” أغمض عليّ القلب”، التي تقول فيها:
“كأنك الجهر وأنا الخفاء كأنك أنا، وأنا ظلي”.
وعلى طريق هذا التفاعل الشعري بين الأضداد، تمشي الأنوثة ذات التواضع الرومانسي وذات الكبرياء الشعري أمام الطبيعة؛ فنستمع في قصيدة: “العصفور الناسك” لهذه الغنائية الهادئة والصافية:
“أنا الأقلّ من خفقة عصفور، والأضلّ من خيال ريشة، والأرقّ من بصمة ضوء على المياه”.
كمرآة في ذهنها فحوى الحواسّ:
تستخدم الشاعرة نوّار كلمة “ذهن” في ثمانية مواضع خلال قصائد المجموعة، وقد استدعت هذه الملاحظة تمريرَ اليدِ داخل السياق للمسِه ومعرفة أبعاد الكلمة؛ فكان معناها في كل مرّة يشير إلى صفاء القريحة وطراوة الغموض بالايروتيكا ونشوة المزاج. فضلا عن التمتع برؤية الإيروتيكيا خلال فنّ إضافة الشاعرة العناصر(كالماء) للذهن؛ لأجل إنتاج وتوليد جماليات الحرارة والنضج الجسدي الشعري ووصال الآخر، في الطرف البارد البعيد، بإشاعة غنائية الحبّ والصفاء المخلوقة من ثلاثية الماء والجمر والحليب:
” من ذهن الماء تقطفني فاكهةَ جمر بفم فجّ يسكب حليبَه من عطشٍ”.
وهذه الفنون سوف تبدّد شعور الخوف من الماء، أثناء تحولات الجسد. فمن الخوف إلى اتّقاد شهوة البحر في الرمل. وهذا الإقدام الايروتيكي يظلّ قادرًا على التمسّك بذرائعه للنجاة، ووصْل برودة الأرض ويبابها بروح الغمام. إنها صلاة في الظلّ للسماويّ؛ لوصال الرمل وخلق الحبّ من الصلصال:
“يا روح الحُبّ في الغمام صيّرْ الحُبّ من صلصال”،
وهذا هو ما رفعته الشاعرة، في قصيدة ” صلاة للحالم بجنية البحر” للسماء. وأما في قصيدة “على بُعْد شمس”، فقد كانت غنائية القدرة على خلق تحولات الكون بالطاقة الايروتيكية لدى شاعرة التراب هكذا :
” ابتعد فأنا حين أشتهي البحر كل شيء يغدو رمليا فيّ كل شيء.”
إلى جانب ذلك، ثمة التذاذ بفنّ إيواء الحسّي في الذهن وصدورِه عنه؛ أي الصفاءَ والجوهرَ والنشوة والمرآة .. فلتركيبة “ذهن الماءِ” ايقاع الأنوثة التي:
“مياهها صافية وثوبها يعكس الخرير”.
كما يشير استخدام الشاعرة المتكرر لكلمة “ذهن” إلى تشكيل ورسم وصقل الآنية والخارطة والمرآة، بفعل النبيذ الأزرق الكوني؛ إضافة لحرية المخيلة بشرودها وسياحتها، وسفر الذهن وحلوله في نبيذ الذات.. وفي امتداد زرقة البحار والمحيطات. أو نفاذه وحلوله في حجر قريب، وتحوّله من علانية الصفاءِ والشفافية في متناول الحواس، إلى الغموض والإقامة كجوهر، كسرّ، يغذّي مخيلة الحواس، كلما أغمض، على سره، وامّحى في الضوء، كـ” يد محفوفة بالعشق” .. ”
كأنها آية رمل في كتاب الريح ولا يزيدها الضوء إلا إمّحاء”..
حيث في قصيدة “في غربة الظل” : ” بعيدة المراكب عن ذهن المياه وها الحجر يشعّ بعماء سره”، وفي قصيدة “جوع بلا قرار”: ” من ذهن شريد تدوم فيه الصيحات” ، في قصيدة “يد محفوفة بالعشق”: ” لمستكِ فضاء لا يُسبر باللمس أراني وأسمعني وأشمّني وأتذوقني أنا القليلة فيها كطير كذرّة غبار في ذهن الخارطة”، في قصيدة ” غابة الرخام”: ” وحدي على أرصفتك يا روما ثمرة نسيان عظامك تَعصف بالذاكرة وأنا حبر يمّحي عن ذهن الشطآن”، في قصيدة ” لأنكَ قلبي”: ” من ينقّب في الثلج عن حُروقِ شمسٍ علقت في ذهن الجرار”، وأخيرًا في قصيدة” أهزوجة خادمة في منام الجسد” تقول الشاعرة :
“متروكة كالأسى في البحر للصياد كمرآة في ذهنها فحوى الحواس وكنت لا أُحْدَس أو أُسْتَشَفُ لا أُقتَضَبُ أو أُكَثّفُ لا أُراوَدُ أو أُسْتَعافُ متروكة في بُعْدٍ يُجْهَلُ أنّي فيه أُجْهَلُ أحيا بموات يقظتي كخشخاش “عمر الخيام”: خادمةُ طيورٍ /وجسدي يُؤكلُ لفرطِ المنام”.
وبذا، فإنّ الغموض ليس موضوعًا مقصودًا في القصائد، بل هو نتاج خصيصة رفض العيش في الأضواء، وهو، تاليا، نتاج تزاحم أنشطة الحواس والشعور فيما بينها، تاركة الشاعرة لنا قصائد عالية الكثافة، تغمس ذهن القارىء بطراوة الغموض وتلفحه بفحوى الحواس. فيصبح الغموض كذات امتدادًا يفتح المدى على الاستقبال والتأويل، ومن طريق ذلك هو” وصال المسافات” .. بالكلمات.
(7)
قراءة ثانية في “نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج” لآمال نـوار البجعة تحبّر الفضاء بشغب الكلمات
راسم المدهون (سوريا – لبنان)
النهار - 13 تشرين الثاني 2007
قصائد الشاعرة اللبنانية آمال نوار الجديدة “نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج” (منشورات دار النهضة العربية)، موار داخلي يفارق كل صخب ويبتعد عن كل هتاف يمكن أن تحمله اللغة الشعرية أو تؤسسه بنائية الجملة في استرسالها. هي قصائد تذهب نحو الحياة ذاتها، فمن هناك تبدأ لعبة الشعر في اختيار اللغة “البسيطة” والتي تصنع شعريتها من “مناخ” ومن استقراء لدلالات الأشياء، الموجودات الطبيعية، الآخر، وأيضا هواجس الروح وانشغالاتها، من دون أن ننسى الإغتراب الذي قد لا تفصح عنه القصائد في هتاف مباشر لكنها تحاوره، تستدعيه وتوجّه إليه خطابا بالغ الشفافية وبسيط الكلام.
تعزف آمال نوار عن “تركيب” قصيدة شعرية متعددة الصوت، وتؤثر خطابها الهامس والمنسوج من حرير إصغائها الى روحها الداخلية التي تزدحم فيها أهواء ورغبات، أفكار وأحزان، ثم الأهم من هذا كله قراءة الشاعرة للعالم الذي يحوطها ونراه، أو نرى إنعكاس صوره وأثرها بين السطور محتدما، وإن في صور بالغة “الهدوء”، سهلة البنائية: “ابتعد/ فأنا حين أشتهي البحر/ كل شيء يغدو رمليا فيّ،/ كل شيء”.
تبدو آمال نوار الأقل “صنعة” و”حرفية” من سواها، فالشاعرة تنشغل بالتعبير عن حياة داخلية تعيشها، بما فيها من صور ليست حقيقية تماما، وإن تكن بقليل من التأمل تعبّر عن ضجيج الروح وصخبها واحتدام أوارها، ولكن ليس بتلك الكيفية التي تبني جملة شعرية خارجية وذات رنين. لغتها أقرب إلى “مونولوغ” داخلي ينبع من رغبة عارمة في البوح وفي “القص”، بالمعنى الذي يشير إلى نوع من الكلام المفعم بدلالاته وحضور ظلاله. يلفت في ديوانها الحضور الكثيف لـ”المشهد” الواقعي، تستحضره الحدقة الشعرية من عدسة داخلية ترى الأشياء والموجودات والتفاصيل كما تبدو في المتخيل لا كما هي في الواقع والحياة.
يلتفت القارئ بانتباه إلى كثافة الصورة الشعرية التي تحمل دوما شغفا يقول الكثير من لعبة المزاوجة بين الفكرة والمخيلة. في قصيدة “من أجل الإنتظار” جمل تؤسس كل منها “صورة” أو “مشهدا” مكتملا بذاته، لنجدها في استرسال القصيدة قد أخذت مكانها حجرا في بناء متكامل هو المشهد العام، وهو قوام القصيدة وجوهر تشكيلها، حيث تنفتح اللغة على دلالاتها فتأخذ أشكالها التعبيرية في حيوية تجعلها قابلة للحياة كما للقراءة والإستعادة: “إنتظرتك/ وكان للوقت رائحة العنب/ إذ يتلوى في الصدور/ وأنا في نعاس غرفتي/ تتقصّف فيَّ الغابات،/ وكنت على طول لحظتي/ أتمدّد/ كمركب أسكره الحنين”.
ثمة في هذا المقطع ما يشبه رغبة قصوى في البوح بالحب أمام آخر يحضر هنا بقوة وإن من خلال غيابه. تلامس الشاعرة مشهدية بوحها وتقصد أن تعبّر عنه بجمل شعرية نسيجها الأهم الصورة في تكوّن درامي يملك “سطوة” التحدث مع القارئ و”مناوشة” مخيلته وفكره على حد سواء. هذه ربما أهم “مفردات” قصيدة آمال نوار حيث الاسترسال الذي يزاوج الشعرية بالنثرية من دون أن يغفل التشكيل، فتستفيد منه الشاعرة في تنويع “موضوعات” قصائدها التي تتجوّل بحرية بين هموم شديدة الإلتصاق بالذات وفيها الكثير من الرغبة في تقديم صورتها وملامح أساها. هي قصائد تقوم على الرغبة في إعادة تصور ما يحدث، ثم الرغبة لاحقا في رسمه باللغة والكلمات. تكتب آمال نوار الهاجس كأنه “حقيقة” واقعية، وتعيد رسم الواقع كأنه صورة من الخيال، وهي خلال ذلك كله تنتبه إلى مركزية التعبير “البسيط”: “انتظرتك/ وأنا في الأقاصي من البحيرات،/ بجعة هائمة بين قصب الشفاه/ تنحني لضوء مسائك،/ بجعة تغرف الأزرق من الكلمات،/ لتحبّر فضاء نومك”.
هنا “تخبر” القصيدة أو “تقص”، لكن تكثيف اللغة الشعرية وتركيز الصورة يحملان معا إلى مشهدية كاملة الأبعاد وفيها الكثير من قوّة حضور الشعرية، عصب القصيدة ومادتها الأهم. تنجح المجموعة في كتابة ذات جناحين، واحدهما هو الشكل المنسوج من ألوان زاهية جميلة ومعبّرة، والآخر قوة المعنى والفكرة المبتكرة والمؤسسة على “وعي” اللحظة لا بآنيتها ولكن بقابليتها لأن تكون جزءا من الحياة المقبلة التي يأخذها الشعر إلى بداهات من حزن المخيلة وعصفها الجميل في الروح والوجدان. هذا كله إلى الحد الذي تغدو معه القصيدة دهشة الشاعرة بالعالم ودهشتها باللغة وسعيها الذي لا يتوقف للقبض على اللحظة والتعبير عنها بوصفها حياة متكاملة وذات أبعاد حيوية تنتقل بدورها الى القارئ بيسر وجمالية.
توقفت طويلا أمام شطر صغير من قصيدة “من أجل الإنتظار”، نرى خلاله قوة المشهد الشعري إذ ترسمه الصورة: “انتظرتك/ ولم أسمع لخطاك نواحا بين حجارة قلبي،/ ولم أسمع قلبي البلا خبز يستغيث”.
كتابة نوار الشعرية “تبث” اغترابها بهدوء حتى لا نكاد نعثر على خطاب مباشر ومحدد عن هذا الإغتراب لكننا نحسّه حاضرا في قصائد المجموعة كلها. هو حضور يبدو كذلك بسبب من مزاوجة إغتراب يخلقه المكان بآخر يسكن الروح ولا يتصل بأيّ مكان أو جغرافيا. الشاعرة خلال ذلك، تكتب وجع روحها وغربتها كما تعيشها وكما تعصف بها. فالإغتراب وجوديّ، يؤسسه الإحساس وتخلقه “الحالة” التي تذهب بعيدا في قراءة لوحته وفي استنطاق دلالاتها في الروح والقلب معا. من البديهي أن نلحظ أيضا أن هذا الإغتراب إذ يعصف بكيان الشاعرة المرأة هو أيضا نوع من بلاغة حضور الآخر، الرجل والحبيب الغائب دوما ولكن الحاضر بقوة والذي نراه في “غيابه” سيد القصائد و”بطلها”، تتوجه إليه ويشبه هنا نقطة ضوء بعيدة وخافتة لكنها حاضرة وتشير إلى عالم من المشاعر والرغبات والهواجس والأفكار والأحلام المفعمة بالحب: “يا أنت/ يا روح الشجر في القبلات/ خذ رغبتي من حواس الحجر/ يختلط فيها دم الشمس بدم السواد،/ يا بكاء تكدس في نهديَّ من قبل أن يصير دمعتك”.
إذ تكتب نوار ذلك كله، فإنما تصدر عن تأمل في مرايا روحها الداخلية، وهي تفعل ذلك برشاقة وبلغة فيها الكثير من حقيقية التعبير، وهي في الوقت نفسه تفارق مألوف القصيدة “النسائية”. فالشاعرة تكتب “أنوثتها الشعرية” ببلاغة مغايرة وتعبر عنها بصدق يجعلها قصائد إنسانية، وهي بلاغة تستمد حضورها من وعي الإنتباه إلى قيمة الجملة الشعرية في أدوات نسيجها وفي مفردات تشكيلها بحيوية تسمح لها بالإحاطة بالمعنى والجمالية معا.
يلاحظ القارئ حضور الطبيعة بكثافة تعادل حضور الحبيب الغائب في رؤية شعرية ترى الإنسان في علاقته بتلك الطبيعة وما فيها من أمل وخيبة، من عصف يشتبك مع الروح ومن انشغالاتها وحيرتها وحزنها. الطبيعة هنا هي مسرح الحياة وهي فضاء العلاقة الأبدية بين حواء المعاصرة ونصفها الآخر، التائه في القصائد. إنها شعرية الوجد الجميل حين تكتبه الذاكرة والمخيلة معا، في نسيج من فنية تحيط بالمعنى وتأخذه إلى ضفاف من حيوية الشعر ورشاقته ووصوله الى القارئ في إطارات شكلية جميلة وذات حضور حار.“نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج”، قصائد حياة “تزدهر” في اللغة، وفي اللغة تؤسس حضورا بهيا لشاعرة نحب أن نقرأ قصائدها.
(8)
“نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج” لآمال نوّار صيد الشوق
شادي علاء الدين (لبنان)
(ملحق النهار الثقافي) سبتمر /2007
تمارس آمال نوّار في ديوانها “نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج”، الصادر حديثاً عن “دار النهضة العربية” لعبة المسافة. تجعل الأشياء بعيدة لكي تنظر إليها بعين الشوق التي تريدها أن تكون أيضاً عين الكتابة. الشوق وفق تحديد باتاي هو إنفاق غير منتج ينجم عنه أقصى خسارة ممكنة. يقول: “إذا كان الشوق قوة محضاً، فضيلة معطاء، فإنها دائماً قوة تخطئ هدفها”. الشوق ليس نظام كنز ومراكمة، إنه كرم من دون حدود، لذا هو لا يمتلئ البتة لأنه دائماً في حالة جوع. فقر الشوق هو غنى الكتابة، إذ أن المسافة الناقصة دوماً بين الشوق وموضوعه هي مكان إقامة الكلمات التي تحاول عبثاً كتابة الشوق فلا تستطيع إلا التقاط بعض أحواله. من هنا نفهم هذا الإتكاء الدائم على الماء لحمل عناصر الحراك الدائم، فالنص هو دائما في حالة سيلان. السيلان هو الحركة التي تختار الشاعرة أن تكون هي الحركة الناظمة لتشكل النص دلالياً وأسلوبياً. لا دلالة جامدة يمكن تحديدها بشكل صارم، بل هناك دائماً نظام علاقات مفتوح لا يطمح إلى إقامة جبرية في أسر الموضوع. الأسلوب كذلك يقيم في وضعية السيلان ويتبناها، فالعنصر المائي حاضر في البنية التركيبية للقصائد، ما يجعلها قادرة على أن تكون هادرة وشفافة ورقيقة وغاضبة في آن واحد. تؤسس هذه العناصر كلها لصيد خاص هو صيد الشوق بواسطة إنفاق النفس وتعميق الخسارات. هكذا ينكتب السفر وتصبح المسافة المأهولة بتبدد الوجهات هي حياة القصيدة وعنوانها.
تقول نوّار في قصيدة “يد محفوفة بالعشق”: “يدك التي أكتبها وتكتبني/ كما لو كوكب يضيء كوكباً بالحبر/ بأسرار الطير والمسافات/ بخيال ناسكٍ يرمي صنارته في البحر/ من أعالي الجبال/ يدك صيدي/ ويدي صيدك/ خاويتان، لكن،/ يصفو بحنانهما/ وجه السماء”. الحبر حين يضيء متخذاً لنفسه موضوعاً، فإنه لا يطمح الى التعبير عن ذلك الموضوع بل دائماً ما تكون الموضوعات بالنسبة الى الحبر هي ذريعة للكتابة. حين تنكتب تمّحي، فالكتابة هي هدف نفسها. لذلك هي تقيم في السر، ولكن أيّ سر؟ إنه سر المسافة الذي يتجلى في هذا المقطع عبر تلاحق صوري، فأسرار الطير وخيال الناسك والبحر واعالي الجبال هي مسافات.
لم تترك الشاعرة مجالاً من مجالات تجلي المسافة إلا أدخلته في النص وفق صيغة صورة شعرية. استعملت دلالات المسافة الحلمية (الطير) في وصفها نزوعاً إلى الحلم والحرية، يرتبط بطابع طفولي لا عقلاني وطائش، على ما يقول التحليل النفسي عن أحلام الطيران. ذكرت المسافة باسمها الواضح أيضاً فمتنت حضورها وقوته. صنعت أيضاً خطاب مسافة ذا ركنين، مادي (ارتفاع الجبال وعمق البحر) وذهني (الخيال). يشفّ هذا التراكم كلّه ليفتح الباب أمام نهاية تبدو مفاجئة، إذ لا وصول بل تصعيد أقصى للبعد يتمثل في الخواء في وصفه مسافة مطلقة لا بداية ولا نهاية لها.
الأيدي الخاوية التي يقدمها النص كغنائم لرحلة الصيد الطويلة والشاقة في مجاهل البعد، تقفل النص على مفهوم خسارة كاملة. هنا بالتحديد يكون الكلام محض شعر صافٍ، لأن هذه الخسارة التي تستطيع جلاء وجه السماء هي خسارة تامة تستطيع بدورها أن تجعل الشعر يكون تاماً كذلك. لقد تم التخلص من كل نظام للامتلاك، فيد الحبيب المصطادة كانت مملوكة في الأساس للحبيبة، وكذلك يدها كانت مملوكة في الأساس للعاشق. عملية الصيد هذه تنفي نظام الإمتلاك الذي يكون مقبولاً كمقدمة للعشق فقط ولكنه حين ينمو فلا شيء يبقى فيه سوى الوهب الدائم والفقد. هكذا يأتي الخواء ليتمم معادلة الإنفاق الذي لا يطمح إلى الربح بل إلى دوام أحواله.
الشوق إلى الشوق يبدو واضحا أشد الوضوح في قصيدة أخرى عنوانها “من أجل الإنتظار”. المقطع الأخير من هذه القصيدة هو بيان يشرح كيفية تشكل الكتابة والعناصر التي تبني عليها نظامها.
لا تستطيع قصص الحب المنجزة أن تكون كتابة، ذلك لأنها لا تملك القدرة على الوصول إلينا. هي تفقد بنجاحها الطابع الذي يجعلها صالحة لتكون سرداً. تفقد المأسوي وتتحول إلى بنية للامتلاك، يصبح الطرفان فيها يمتلكان علاقتهما وذلك على العكس من قصص الحب غير المنجزة حيث يكون الطرفان فيها ملكا للشوق نفسه. يقول هذا المقطع: “انتظرتك/ ولم أسمع لخطاك نواحاً بين حجارة قلبي،/ ولم أسمع قلبي البلا خبز يستغيث./ انتظرتك من أجل الإنتظار فقط،/ من أجل فحم الأرض وجوع السماء،/ من أجل تزيين قلوب الموتى/ على العتبات،/ ومن أجل سرقة الورد من ذاكرة الأيدي./ انتظرتك/ ولم أكن أنتظرك/ ولم أكن أعرفك/ وكان جميلاً أن لا تأتي/ فآتيك بقصيدة”. لا ألم يزهر على العتبات. الألم في الوصول، وهو وجع الزهرة المقطوفة وخيبة المنجز. لذا لا يكون الإنتظار هو الوسيلة بل الغاية، وهو في كل لحظة يبتكر طقوسه وأهدافه. إنه برق يزيّن قلوب شهداء العشق ويفتت ذاكرة الإمتلاك. هذ الإنتظار المفتوح الذي هو هدف نفسه، ليس إلا الشوق الذي يكمن جماله في أنه لا يكتمل، وبذا يسمح للقصيدة أن تكتمل في نقصانه.
(9)
الكتابة على حافة الألم والسير في متاهات المرايا الشاعرة اللبنانية أمال نوار في ديوانها الجديد: “نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج”
نورالدين محقق (المغرب)
الحياة الجديدة / موقع جهة الشعر في 2007
صدر حديثا عن دار النهضة العربية في بيروت (2007) ديوان جديد للشاعرة اللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية أمال نوار عنونته بجملة اسمية معطوفة على أخرى فعلية في تركيب شاعري فائق التميز هو كالتالي “نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج”.هذا العنوان الذي يحتفي بالنبيذ في أرفع معانيه الإنسانية التي تحيل على المعاني الصوفية له و التي تعبر عن الامتزاج بالذات في صفائها الروحي كما سنجد في ثنايا قصائد الديوان ، إضافة إلى كون هذا النبيذ يؤثث فضاء الزجاج المعبر عن الشفافية التي تظهر معالم هذا النبيذ في كامل صفائه الشعري . هذا الصفاء الذي تعكسه القصائد بكثير من الصدق وكثير من البوح الممتلئ بالألم.
يأتي هذا الديوان الذي يشكل التجربة الثانية في مسيرة الشاعرة أمال نوار بعد ديوانها الأول “تاج على الحافة” الذي صدر عن دار الفارابي في بيروت (2004) والذي تناولته مجموعة من الأقلام النقدية العربية بالدراسة والتحليل مشيدة بالعوالم الشعرية التي شيدها، هذه العوالم التي تغوص في الذات مستنبطة آمالها وأحلامها متوقفة عند آلامها وجروحاتها، وهو الأمر الذي نجد أن الشاعرة أيضا قد غاصت فيه من جديد في ديوانها الثاني “نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج” لكن بنوع من الحساسية المفرطة تجاه الكون الذي يحيط بها، والعمق الذي يتجاوز مسألة الكلام أو البوح إلى مسألة الاستشراف والنظر البعيد والتنبؤ بما قد يحدث للألم ذاته وهو يعتصر وجدانها الداخلي بكثير من العنف إنما بكثير من اللذة أيضاً المصاحبة له في عنفه الرمزي هذا ..إن الشاعرة هنا في هذا الديوان وهي تحتفي بالنبيذ في لونه الأزرق لا الأحمر، ولا الأبيض كما هو متوقع ، تخترق بنية المعتاد وتتجاوزها نحو ما هو رمزي ، إذ اللون الأزرق هو اللون الأكثر عمقا بين الألوان كما يخبرنا كل من جون شوفاليي وألان غيرباران في كتابهما “معجم الأساطير” وهي باحتفائها به ليس في العنوان فحسب بل في كثير من القصائد تكون قد احتفت بالعمق الإنساني المعبر عنه في هدوئه ونقائه وفي تجلياته بحرا وجوا وأرضا .تقول الشاعرة في هذا المعنى ما يلي: “رأيتكَ وأنا في زجاجة تائهة فيك/أهفو إلى سمائك من شِبَاك ماضيك/رأيتُ قلبي جنيناً أزرق/يسبحُ في أحشائك/من قبل أن أُولد”.هكذا يتحول اللون الأزرق إلى لون الحب ، لون اللوعة المستعرة في النفس، لون الطهارة الإنسانية التي تتجلى في عواطف إنسانية تتسم بالرومانسية في أجلى معانيها. وهي في عملية بحثها عن تجليات هذا اللون تريد أن تراه في أحلامها وفي ثنايا كتاباتها المعبرة عنه كأصدق وأبعد ما يكون التعبير، تريد أن تراه متجليا في متاهات مراياها شفافا كضوء يأتي من بعيد، كوهم يتراءى ليختفي لحظة الرغبة في القبض عليه. تقول الشاعرة معبرة عن ذلك في كلمات شديدة الشاعرية ما يلي : ” لكأنّي كلما شفِّ زجاجُي/تعتّقِ فيّ الَوَهْم/مكتومٌ عِنبي في خَوَاء نظرتي/ يتّقد وفمي طافحٌ بالثلج/مُتراصٌّ حناني/ظمأ إلى ظمأ في قسْوةِ الخشب/وما مِنْ بحرٍ تسكبُ فيه الوَحْشةُ دمَها/يتشرّبُ النهرُ /خريرَ حواسّه/يُجففُ ذاكرتَه في الهواء/ولا يبقى في جَوْفه غير مرارةِ حصى/َيسْوَدُّ بالنسيان/صِنّارتي لا يطالها ضوء قستُ خيالَها بحُطامي/لكنْ/لا جذور لمَنْ لفظَ جرحي من جرحه/ومشى عَطَشاً على ماء/يجفُّ واحدهما في قلبِ الآخر/وما ظننتني نَسْغه/أغورُ فيه منذ عصور/أحبّرُ النومَ والظلال…”
إن صور الشاعرة أمال نوار تنساب في هدوء معتمدة في عملية تشييد بنيانها الشعري على جمل محكمة الصنع تنزاح الصفات فيها عن المعتاد وتغوص في التراكيب التأملية التي تمنحها عمقا في الرؤى وتجعلها صورا شعرية جديدة لا تنتمي إلى نوع الصور الشعرية المكررة لدى بعض الشعراء الجدد والتي أصبحت من كثرة اللجوء إليها صورا باهتة الظلال. صور الشاعرة أمال نوار تجمع بين الحس الرومانسي في شفافيته وبين العمق الصوفي في تعددية إحالاته الرمزية وهو ما يجعل منها شاعرة مختلفة، لها لغتها الخاصة وتعابيرها الذاتية ، كما أنها لا تلجأ في صوغ صورها هاتها إلى الرموز الأسطورية المعروفة لتعيد صياغتها من جديد بل تبحث عن كتابة أساطير ذاتية، تعتمد في عملية تكوينها على تجاربها الشخصية لا غير. تقول في هذا المعنى ما يلي: “هناك في العمق البلّوري لصدركَ/أرقدُ لغةً قديمة في عُصور النوم./هناك حيث الفخّار يُمزّقُ قلبَه/ليظلّ جنينَ النار،/وحيث حجر البحر يتقد بحجر السماء/كلما تشظّى في ضلوعكَ موجٌ/دوّتْ في مناماتي جِرار/وهوى ألمي فوق جذوعِ ألمك/غابةً تُوقظُ في صمتكَ فأسا/وفي شرودي نايات.”
تحضر في هذا الديوان مجموعة من الرموز الشعرية كرمز الماء والجناح والحبر والصمت التي تحاول الشاعرة بها ومن خلالها التعبير عن أفقها الشعري الذي يتجلى في مديح الألم وجعله نافذة للعبور إلى ظلال العالم بدل السكن فيه والمكوث في ثباته، إضافة إلى اللون الأزرق في تعبيريته الرمزية التي سبق الإشارة إليها والنبيذ في قوته الإيحائية التي جعلتها الشاعرة تنحاز إلى جهة التصوف الرمزي بدل التعبيرية الواقعية والزجاج الشفاف الذي يحيل على النفس في صفائها، وكل هذه الرموز تأتي في طيات القصائد الشعرية ملتحمة بها ومنسجمة مع البنيان الشعري المؤثث لمختلف فضاءاتها مما يجعل منها رموزا شعرية ترتبط بهذه القصائد بشكل بنيوي كلي . وهو الأمر الذي يحسب لهذه التجربة الشعرية التي بدأت تعرف إشعاعا عربيا لافتا للنظر.
إن ديوان “نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج” هو إضافة نوعية للتجربة الشعرية اللبنانية والعربية في تعدديتها وبحثها المستمر عن آفاق جديدة وهو إضافة متميزة لقصيدة النثر العربية في بحثها المستمر عن الخصوصية والتعبير الشعري المنبثق من الداخل في عمقه الرؤيوي وقوة العوالم الشعرية التي يؤسسها. وبإصداره هو الآخر تكون دار النهضة العربية مازالت تعلن عن إصرارها الجميل في الاحتفاء بالشعر العربي وبالتجارب المتميزة فيه.
(10)
آمال نوّار شاعرة تستخرج القصيدة من منجم اللغة والحياة
رامي الأمين (لبنان)
الحياة - 18/10/07
ما المطلوب من القصيدة غير تلك النزهات التي تأخذنا فيها الى عوالمها الخاصة، أياً تكن هذه العوالم؟ ثم إن النزهات تجوال في المجهول، وجلوس في المطلق، ونظر إلى المستحيل. والنزهات طل وأحاديث وضياع واستفسار، النزهات أيضاً اسئلة الغياب وأجوبة العدم. القصيدة غربة وانتماء، زمن اللازمن، القصيدة حلم بعيد. الشاعرة اللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة أمال نوّار في كتابها «نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج» الصادر حديثاً لدى «دار النهضة العربية» حالمة بدرجة عالية من الهذيان الواعي، الفردي، الغرائبي والتخييلي. تستخرج الشعر من منجمه الحقيقي، وتبعثه ثميناً في القصيدة، يلمع ويتوهّج وينعكس على الزجاج والماء والكأس والمرايا. تعرف آمال نوّار كيف تصنع ضوء قصيدتها، أو أنها على يقين من أهمية الضوء والألوان في تكوين القصيدة، ولهذا اختارت أن تعطي النبيذ لوناً أزرق يؤنس النظر والزجاج. إنها ترسم بالكلمات، بحسب تعبير نزار قباني، لا ترسم فحسب، بل تلوّن وتصحح، وتنظر طويلاً في لوحاتها، وتستطيع أن ترى الأبعاد، أن تلحظ النقاط الغامضة والمعتمة، وتضيئها بألوان فاتحة، بضربة عمياء من ريشتها: «بعيدة المراكب عن ذهن المياه/ وها الحجر يشعّ بعماء سرّه». لا ترسم وتلوّن فحسب، بل هي تقول، وتحسن القول، تنطق بالحكمة في مواضع كثيرة من كتابها، أي أنها تهبنا نظرتها إلى الأمور، نظرة الشاعرة التي تلتقط مركز العطب من الأمور: «الكيان لا يُسمع حفيفه/ في صخب الصمت،/ الجسد أيضاً يدور/ ولا تشعر به الأرض».
لكن هذا الأسلوب، على نزقه وغرائبيته، يبدو مألوفاً، بصفته نوعاً شائعاً من الكتابة الشعرية، التي تعتمد الاستعارات والتشابيه والصور الغريبة أساساً في تكوينها. فالبحر عند أمال نوّار «دمعة في عين الشمس»، وهي تتمدد «كمركب أسكره الحنين»، بل هي «بجعة هائمة بين قصب الشفاه»… كلها تعابير وتشابيه تصب في خانة واحدة، وتخرج من حقل لغويّ واحد، كما أن نصّها يجنح نحو رومنطيقية ما، تعود بها إلى الطبيعة، إلى البحر والسماء والشجر والهواء والحجر، تأخذ كلماتها من انعكاس هذه العناصر في مراياها الشعرية: «يا روح الشجر في القبلات/ خذ رغبتي من حواسّ الحجر». كأنها تخاطب الرجل مباشرة، طرف القصيدة الآخر، و «تغمسه» في ماء قصيدتها السريّ: «أيا أنت، يا نجمة بعيدة تغمس قلبها/ في ماء روحي». لاحظوا تشبيه الحبيب بالنجمة البعيدة، وكأن الأمر هنا ضروري بالنسبة إلى الشاعرة، إذ لا تستطيع أن تخرج من تشابيهها، ومن إسقاط الطبيعة على كل شيء. كان في إمكانها ألا تشبّه رجلها بالنجمة. كان من الممكن أن يبقى رجلاً، وأن يغمس قلبه في ماء روحها. والرجل حاضر دوماً في قصائدها بصفته الحبيب، أو بصفته هالة من سحر، رجلاً من خيال، من ضوء كثير، يسكن «سماء أعماق» الشاعرة، جسده «عاصفة في صمت محبرة»، وقلبه «يوقظ النوم بصهيله، لكن…». يظهر الرجل في النهاية، على أنه سراب ليس إلا. تعرف الشاعرة إذاً أنها ترسم من الرجل ظلّه، أو غيابه، أو احتمال حضوره. لكنّ ما يحسب لها، هو قدرتها على الملاءمة بين خيال اللغة ولغة الخيال، فلا تضيّع البوصلة، وتنجح في بناء لغة متماسكة، جميلة وسلسة، تعرف طريقها جيداً وتؤنس قارئها.
تحاول أمال نوّار أن تهرب من الكتابة اليومية الروتينية، ومن التقاط الأشياء التي تحيط بها. هي لا تلمس أو تسمع أو تشمّ الأشياء، بل تراها بصورها المموهة فحسب. ترفض أن ترى بعينها الأمّ، فترى ببصيرتها، وتقفز بخيالها فوق سور الواقع العادي الرتيب، لكنها تسقط في الخيال المستحيل، ذلك الخيال الذي يشبه قصص «ألف ليلة وليلة»، أو قصص السندباد، خيال جميل لكنه لا ينطلق من قاعدة الواقع. إنه خيال يسبح وحيداً في الفضاء، غير آبه بالجاذبية. تحكي قصصها، أو مناماتها وتهيؤاتها: «جاءني طير في المنام ينقر وردتي/ تلسعه الأشواك بملحها/ فيتخدّر فيه القصب».
لكنها في بعض القصائد تنجح في الفرار والنجاة، مع موازنتها بين الواقع والخيال، كأن تجد قضية لكتابتها، أقصد قضية غير الخيال والركض وراءه، قضية الوقت مثلاً، أو الألم والدمع، أو الضجر والفراغ: «وما أنا إلا دمعة في دمعتي»، أو عندما تكتب عن فراغها ودمعها: «هذا الصباح، شعور بالخواء يملأ روحي…/ دمعتي كبيرة وغامضة/ كقلب هذا العالم الضبابي». أو عندما تتحدث عن الرجل بصورته واقعاً، لا سراباً، غير أنه واقع لا أمل منه، واقع مستحيل، لكنه حقيقي: «أيضاً أراه لا يراني/ رغم أنه تحت جلدي/ بعصاه/ ونظارته السوداء/ ووحشته/ عبثاً ينتظر صحوتي».
لا تكتفي أمال نوّار بتنزيه قارئها في خيالها، بل هي تصحبه إلى أحاسيسها ومشاعرها، وأيضاً إلى لغتها الحلوة، فتسقيه من طلها الأزرق، وتريه ألمها من خلف زجاج عازل.
(11)
وصال المسـافات باللجوء إلى منطقة الحلم “نبيذهـا أزرق ويؤنس الزجـاج” لآمال نوّار
محمد العشري (مصر)
النهار _ 21 كانون الثاني 2008
“ثمة محيطات تفصل زجاجي عن الحلم وما من جسر بين الهواء وظلي”. هكذا، تدلف الشاعرة اللبنانية آمال نّوار، إلى ذاتها المستلبة، وهي المسافرة بعيداً في أميركا، لتشكّل من رغبتها في الالتحام بالذات المفقودة في مكان قصي عن عالمها، قصائد مجموعتها الثانية “نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج”، الصادرة حديثاً في بيروت، لدى “دار النهضة العربية”. يبدو تأثير فكرة المواطنة واضحاً، وخصوصاً حين تحيل تلك الذات المغتربة على رماد يخلّفه الحنين المشتعل، وتدهسه أقدام الوحدة، بعيداً عن الآخر، النائم في الذاكرة. ربما تتبادر إلى ذهن القارئ أسئلة كثيرة، في حاجة إلى إجابات، أو تأمل، وهو يطالع الإنتاج الشعري، لشعراء وشاعرات كثر، يعيشون خارج أوطانهم. تلك الأسئلة تقود إلى استفهامات أخرى. إذ كيف تشعر تلك الذات الخلاّقة بالغربة في وطنها؟! فإذا تركت ذلك الوطن من أجل الراحة، والتحقق، تشعر بغربة أكثر، تجعلها كائنا هشا، يعيش متطلعاً إلى أحلامه، التي ليست في متناول يده، وتوقا جارفا يظلل كل حركة يخطوها، بعيداً من إطار الوطن وحدوده: “أراني في مرآة الغياب/ تطفو نظرتي ويغرق بحري”. الإشتغال على تلك المنطقة من الذات المتشظية، في مواجهة غربتها، يحتاج إلى وقوف راصد لعلامات، ودلالات في النفس، ربما تؤدي إلى معرفة أكثر بما يعتمل في الداخل “الإنساني” من اتزان موقت، وتأرجح لا يهدأ. بين ما هو معيش، وفي متناول اليد، وبين ما هو غائب في المكان والذاكرة: “لكم ترنحت في جسدي تماثيل لهب،/ لكن حناني لم يكس التراب فرواً،/ ولا دفء صوتي علّم الطير السفر/ أنت باردة أيتها الأرض”.
تستفيد آمال نوّار من المدرسة الرومنطيقية في الشعر، ومن شعراء المهجر، من دون أن تسقط في فخ الغنائية والمباشرة، أو تفقد الروح الشعرية المتدفقة، والتي تستقي نثريتها الشاعرة من تلقائيتها وصدقها، في التعبير عن الحالة الشعرية الحديثة، محافظة على كيانها العصري. فهي ابنة جيل جديد مغاير، وفّرت له التكنولوجيا ومخترعاتها ميزات، أهمها أنها قرّبت المسافات، ولم يعد هناك انقطاع تام عن مباشرة الحياة، ومعرفة ما يحدث على أرض الوطن “الأم” كما كان يحدث في الماضي: “خذني/ فأنا أرض مذبوحة بشفرة أفق/ تفصل قبلاتنا غربة الزجاج”. تلك الروح المحترقة في منفاها، يقتلها العطش، والحاجة إلى الانصهار في كيان عاشق، تستعيض عن تحقيقه الواقعي باللجوء إلى الحلم: “اغمد ريشاتك في فمي،/ وحبّرني سماء فوق مرآة نومك”. ولا تلبث أن تتسع هوة ذلك الحلم، ويغدو تحقيقه أمنية في حاجة إلى صلاة، وتضرّع، من أجل أن يتوحد بها وتتوحد به: “خذني كما تؤخذ البحيرات”. هنا تقع آمال نوّار على المخبأ السري، وتتعمق في تشكيل أساطير وحكايات، يتوالد بعضها من البعض. وهو ملمح سردي مكثّف، يبين في الكثير من قصائد المجموعة، وتنسج عليه نوّار بمهارة وإيجاز: “وأرى ملاكاً من ريش أصابعنا/ يضم الخرائط بجناح/ والزمن بجناح/ ليضيّق الفضاء بيننا”.
تكتنف قصائد آمال نوّار مسحة من غموض، يجعل القارئ في حال تفاعل مستمر معها، تدفعه الرغبة في المعرفة والاكتشاف. فثمة ذات خبيرة، تمتلك مفاتيح جيدة، لمعرفة روحها، وجسدها، وأسباب فرحها ومتعتها: “أسألكَ/ أن توصد عليَّ أبوابك وأسبابك/ كي تنقبض حواسك على الوهج،/ كلما هصرتني بالقيد/ رشح منك الزيت”. وثمة ذات أخرى محلقة، تختبئ خلف دهشتها، وبكارتها في تلقي الحياة، واكتشاف الآخر، بما لديه من خبرة في لمس المتعة والإحساس بها. أو ربما تحاول تلك الذات أن تبدو بريئة، ملائكية، في تعاملها مع الحسي، لإكسابه نزعة روحية، ترتقي بالجسد، كأنها تهبط إلى الأرض بحذر، وتجرّب اللذة بمقدار، من دون أن تنغمس فيها.ثمة محاولات مستمرة في رتق الذاكرة، وإشعالها من أجل تغذية الروح وإدفائها، كي تتماسك في مواجهة الهرب إلى منطقة الأحلام، وإعصار التشظي اليومي: “إذ إلى أين ستهوي الأرض/ وليس تحتها أرض؟!”. وثمة الدوران المريع. هذا وتلك، يفضيان في الضرورة إلى كوابيس حقيقية: “جاءني طير في المنام ينقر وردتي/ تلسعه الأشواك بملحها”. إنتاج آمال نوّار الشعري قليل (صدر لها من قبل “تاج على الحافة” عام 2004)، ميزته التكثيف، يمتص ماءه من جذور عميقة، وينمو في تربة خاصة به، وأرض بكر. ذلك ما يجعلها تنأى بمفرداتها الشعرية واللغوية عما تتضمنه الكثير من القصائد النثرية، المكتوبة في الوقت الحالي، ومعالجاتها المتكررة، وهذا ما يرتفع بقصائد “نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج” إلى نقطة مضيئة في جبين القصيدة النثرية الحديثة.
(12)
نبيذها أزرق
اسكندر حبش (لبنان)
السفير 14 تموز 2007
كان ذلك في النصف الثاني من ثمانينيات القرن المنصرم. كنّا مجموعة شبّان نحلم بأشياء كثيرة، منها الكتابة الشعرية على سبيل المثال. لم نكن نعرف بعد لا الانترنت ولا الإيميل ولا أي شيء آخر من سمات هذا العصر الحديث. لذلك لم يكن متاحا أمامنا سوى صفحات الصحف الثقافية في لبنان ـ وبخاصة صحيفتي «السفير» و«النهار» ـ لننشر فيها قصائدنا التي سهرنا طويلا كي نغزلها وننسجها بعيدا عن الحرب التي كانت تفتك بكل شيء. من بين هؤلاء كلهم كانت آمال نوار. وإن كانت أكثرنا تواريا وابتعادا عن حلقاتنا، فهي تقطن في مدينة صيدا الجنوبية، بينما أغلبنا يسكن بيروت. لم نرها سوى مرات قليلة، لكن قصائدها كانت تصدر بانتظام في الزميلة «النهار» بعناية شاعرنا الكبير شوقي أبي شقرا. نقرأها لنطمئن أيضا الى أنها لا تزال على قيد الحياة، وبخاصة في جولات القصف التي ينقطع فيها كل شيء.
تمضي الأيام، ولا تمضي الكتابة. إذ كانت مشروعنا الذي غرقنا فيه ولم نخرج منه بعد. مع بداية التسعينيات، قالت لي ذات يوم إنها ستهاجر إلى الولايات المتحدة. وهناك انقطعت الأخبار ولم نعد نذكر عنها سوى ما تركته منشورا، لتدخل في دائرة حياة ظننا معها أنها طلقت فيها الكتابة إلى غير رجعة. بيد أنها عادت فجأة بكتاب «تاج على الحافة» (2004)، لنتفاجأ بهذه العبارة الندية التي لم تفقدها، بل كانت قد ازدادت ألقا.
هذا الألق، وهذه العبارة وهذه الصور الجديدة، التي تنثرها في مجموعتها الجديدة «نبيذها أزرق ويؤنس الزجاج» (دار النهضة العربية)، تعيدني مرة أخرى إلى ذاك الماضي الجميل الذي كنا نحلم فيه، على الرغم من قباحة حروبنا المتنقلة. تعيدني إلى هذا البلد الذي لم يفعل شيئا في النهاية إلا تشتيتنا في أصقاع مختلفة، لكنه لم يمنع عنّا الكتابة. لأننا اعتقدنا حقا أن الشعر هو الوحيد الذي يجمع بيننا.
هو فعلا الشعر الذي نقرأه، لنستعيد معه حيواتنا التي تشظت، من هنا، ليس كتاب نوار كتابها وحدها، بل أريد أن أرى فيه عبارة من عبارات هذا الجيل الذي علق على كثير من الحوافي، ولم يجد بدا من العيش.
بالتأكيد لا أكتب نقدا في زاويتي هذه، حول مجموعة آمال الجديدة، بل فقط مجرد تحية لهذا الصوت الذي «يؤنسنا»، الذي كان من المفترض أن يأخذ مساحة أوسع بيننا. لكن لن أقول هي الظروف، بل ثمة مصائر شعرية لا بد من أن ننتبه إليها مجددا.
لننتبه إلى هذا اللون الإضافي الذي يصنع منه النبيذ. فبعد الأحمر والأبيض والروزيه، ثمة لون جـديد، والأهم أن مذاقه طيب ولذيذ.
(13)
ليس ككل الأسماء، أمال نوّار
باسم المرعبي (العراق – السويد)
جريدة إيلاف، الأربعاء 2 مارس 2005
آمال نوّار اسم يسطع إزاء الركام الذي يغتصب اسم الشعر وينتهكه، هي وعْد بمعجزة بل انّ قصائدها لمعجزات صغيرة من الدفء، ممسوسة بشغاف القلب. معجزاتٌ تحيا في ظلّ هواء الروح حيث الألم، اليأس، الإنتظار، الأمل الأزرق المغموس بماء الكلمات، الشغف والفرح بوعد متحقق في الفن ـ أي في قصيدة. بمهارة تحتال على كثبان تئدُ الحلم. هذه هي آمال نوّار.. قصيدة مقتصدة الكلمات، غير انها تقول الكثير لأن أصابعها لا تحترف المناورة لأجل تغطية فَقر المخيلة والقلب، كما هو شائع ودارج، الآن. هي لا تفعل أكثر من الإنصات إلى دواخلها، تتحسّس أحلامها و"عذابها" وتترجم ذلكَ عذوبةً، تهبّ من القلب إلى القلب. كلماتها محسوبة، فلا هذر، ولا ادعاء. تضع قصيدتها المليئة بتواضع وتنصرف، لا ضجيج حول هذا الاسم المنحني على شجن القصيدة والمختلط بها، طالما ان صاحبته مسكونة بنداء الروح ومشرعة حواسها لتتوحد أو تتحد بزرقة اللامتناهي، بعشبةٍ أو ذرة رمل أو "مطرة"، منصتة إلى الصخر والغصن والريش في حفيفه، منصتة الى نومها، إذ "يسودّ الكلام على جلدها"، لتُرينا "أحلامها تتدلّى في الأفق كالجليد من النوافذ"، ونكتشفَ عبر بلاغتها "انّ البحر دمعة في عين الشمس". وانّ طيورها "لا يُرى ولا يُسمع ارتطام الريش في خَلدها". تأخذنا كلماتُها- التي تؤخذ بـ "رشفة قلب"، حسب تعبيرها الحميم، الجميل- الى جهة الريح والأحلام المضرّجة بنُدْب الواقع، الى الأمكنة المأهولة بدمعة والمفتوحة على فراغ الإنتظار مثل شبابيك واجمة، لكن بعيداً عن قَفر النثر ووحشته...
نموذجان:
على بُعد شمس
عينكَ ذهبٌ يا هذا وعيني يباب ابتعدْ كي تراني من عُلُوِ يومي سلسلةَ جبال حُبْلى بالبرتقال. ابتعدْ كي ترى كيف وأنا أنام يسوّدُ الكلامُ على جلدي، وكيف أحلامي تتدلى في الأُفق كالجليد من النوافذ. ابتعدْ كي ترى أنّ البحر دمعة في عين الشمس، وأنّ زُرقتي المُظلمة و البلا قرار لا كلمات ولا أيدٍ تبلغها حيّة، وأنّ العصافير التي تُخلّفها دعساتي فإنه لفرط الصمت يمتلئ خيالي بخيالها. ابتعدْ فأنا حين أشتهي البحر كلّ شيء يغدو رمليّاً فيّ كلّ شيء.
من أجل الإنتظار ( مجتزءات)
انتظرتكَ وأنا في غيمةٍ يحتضرُ فيها الماءُ والعطشُ، وكنتُ أشتعلُ بحُمرةِ بحرٍ يموتُ وفي عينيه سواد الرمال. انتظرتكَ وكان للوقت رائحة العِنَب إذ يتلوّى في الصُدُور، وأنا في نُعاس غُرفتي تتقصّفُ فيّ الغابات، وكنتُ على طول لحظتي أتمدّدُ كمركبٍ أسْكره الحنين. انتظرتكَ وفي يدي حُزن الرماد، لا نهاية لأصابعي إذ تلامسُ الزجاج؛ بغنائِها البعيد كانتْ تُشتهى دونَ أنْ تُقطفُ أو يرتعش فيها زَغب. لا لون للأزل إذ يبرقُ في نظرتي وأنا أخترقُ بصمتي الجَمَاد. الدروبُ السوداء يُضاء عُشبُها تحت دَعْسَتي، والمسافات يتقطّرُ دّمُها من نُقطةِ أمل.
آمال نوّار اسم يقول لنا أن لا نكفّ عن انتظار الشعر، فمهما بدا عصياً أو مغيّباً بفعل مشهد زائف إلاّ ان الشُهب التي تخترق حلكته بين عتمة وأخرى والمشتعلة بوهج الروح هي الوعد الذي ننتظر والذي لن يخلف ضوءه.
(14)
آمال نوّار وكتابة الجسد
قراءة في قصيدة (أُهزوجة خادمة في منام الجسد)
محمد جميل أحمد (السودان)
موقع SudaneseOnline 28 يوليو 2007
طاقة الشعر الحلمية ، كالحلم تماما ، تربك تراتبية الصور المختزنة للذات والعالم . وتخترق حيوات متخيلة بنسيج من خيوط خالقة لعالمها المؤثث بجمالية معـّـقدة ، لها القدرة على القطع والتبديل السريع ، للمألوف . وخلخلة وعي المتلقي لجهة الجذب إلى عوالم داخلية أليفة. يعيد الشاعر بناءها، لاعبر المخيـّـلة فحسب ، بل عبر تكوين قادر على اشتقاق ودمج مناخات وطقوس لأشياء مختلفة ، تنضفر بعكس وجودها الطبيعي أو بخلافه . وترحيل الكلمات عن قاموسها بتحريك جديد من ضغط المعاني المكشوفة أمام التجربة الشعرية . بينما تكف مفردات العالم وعناصره ، بفعل هذه التجربة ، عن تأويلاتها خارج النص . ذلك أن للشعر هنا جوهرا نية فريدة تكشف للشاعر علاقات جديدة تخضع فيها الأشياء والمعاني لحياة شعرية تنقض وجودها السابق وتلتبس بالزمن في رحلة أبدية .
على هذا التأويل تكتب الشاعرة اللبنانية/الأمريكية :آمال نـّـوار ، غوايات ومُتــَع بطاقة حُلميه تشد الجسد إلى مقام صوفي يغرق في المتع ويكف عن تحقيقها في نفس الوقت ، في قصيدتها (أُهزوجة خادمة في منام الجسد) .
حيث تضفر بأناقة جسدية عالمها (الشبقي) الشفاف ضمن تكوين يكثف اللحظة الجسدية في حالات تختبر أقصى مجاهل اللذة ، تلك التي يصقلها الحلم حتى تبدو كقناع يستنفد عصارة الوهم في مرايا اللذات السـٍّرية والمتوحدة ، دون أن تتكسر أو تتحول إلى مسـّرات طينية عابرة . فهي تنزع بكتابة الجسد إلى محايثة الوجود والعدم، واكتشاف لممكنات الجسد الروحية من خلال سيرة العطش . والشاعرة في كتابتها تلك تكشف عن أطياف مغمورة لاتعين على فهم المعاني فحسب ، بل تتحول إلى لقطات يشع منها الشعر من قاع يحيل التجربة إلى رؤيا ، والسرد إلى مناجاة ، والجسد إلى أيقونة ، والرغبات إلى غيوم ماطرة .
(جاءني طير ٌ في المَنَام ينقرُ وردتي .
تلسعُه الأشواكُ بملحِها
فيتخدّرُ فيه القصب .
جاءني يد وزن عيدان المطر
ويُحيلُ رخامي إلى شمعةٍ )
فالنص إذ يدخل في الغواية بصورة تلامس مفرداتها الفعل الإستعاري لوظيفة الجسد . يلتف في نفس الوقت على ذلك الفعل برموز وصور رافعة لتأويله عبر مجاز شفاف ينشط بإشارات تختزن طاقة من الرؤيا تفيض عن المعنى المادي القريب ، إلى اختبار الجسد بوصفه صورة للروح . والمنام كفضاء للتجربة ومكان للحلم ربما كان مناسبا لإطلاق المعاني الصوفية والعرفانية التي يحتفي بها النص ويوظفها . وهو ما يمكن أن يحرر التجربة الجسدية من معاني السلب التي تلتبس أحيانا حالة الحرية في علاقات الجسد الأنثوي . فتنفيها الشاعرة لتحول كتابة الجسد إلى متعة صافية كما لو
كانت تعيد اعتبارا روحيا لعلاقات الجسد ، بهذه الكتابة ، يرفعها إلى مقام شفاف .
( في دَغْشَةٍ
لا يُسْبَرُ في بئرها
شرودَ الغزلان .
وكانتْ خيوطُ الشر اشف
أوتارَ غجر
تلهثُ بألف ليلةٍ من العَطَش
والعطرُ تغيضُ روحُه
في حرير النَفَس ) .
وتوغل الشاعرة في أقاصي الوصف لتحرر رغبتها الأنثوية الحارقة بتجريب يقطـّر طاقة الجسد الملتبسة بالروح فيما يشبه حالة أقنومية فهي تحتفي بالجسد في نسيج روحي مشروط بغفلة المنام ، وهدوء عميق مطمئن ، لاترن فيه سوى (أوتار الغجر) وهو هدوء يقابل عوالم (يوهان فرمير) الحالمة، لكنه يأتي لتجسيد ذلك الأقنوم الذي يحتمل الشفافية والكثافة في ذات واحدة ، وينطوي على تأويل للكينونة الإنسانية الخالصة. والشاعرة تمحو فضاء السرد ،أي المنام، عندما تتوهم الصحو . لكنه صحو داخل سياج الحلم .
(وكنتُ أصحو وأنام وأصحو .
تنخرُني الغرائزُ كخليةِ رمّان .
لا أثر في عُروقي لموهبة
سوى أنّي مغيضُ رغبةٍ
عتمةُ فاكهة)
ذلك أن السرد هنا يحرص على متابعة الوصف بلغة متولهة تختزن اللهفة من أعماق الجسد للإمساك بخيوط المنام ، وحكاية تفاصيل السلب اللذيذ . فالحرص على تماهي لذة الأنثى مع حالة السلب ينطوي على تأويل عميق للأنوثة في أقصى حالات الجسد فهو سلب ينفي كل ما هو خارجه في لحظة الجسد .
غير أن هاجس الحرمان الذي يتكشف من خلال النص هو الحد المقلوب لأقاصي نشوة المنام يطلق إشارات النفي الاحترازية التي تنطوي على دلالة مزدوجة . فهي لاتحيل فقط على اختلاق البراءة فحسب . بل تحيل أيضا على إدراك سحيق ، وذهول يتعالى عن علامات الوعي لفرط لذة الغياب .
(سرّي لا يُـسرُّ لأحد
خوفي لا يُخيفُ أحدا ً
خيانتي لا تخونُ أحدا ً
متروكة كالأسى في البحر للصيّاد
كمرآةٍ في ذُهنها فحوى الحواسّ
وكنتُ لا أ ُ حدَسُ أو أ ُسـْتـَشَفُ
لا أ ُقـْتـَضَبُ أو أ ُ كـَثـَفُ
لا أ ُراوَدُ أو أ ُستـَعَافُ
متروكة في بُعْدٍ يُجْهَل ُ أنّي فيه أ ُجْهَلُ)
والنص يشتغل على تصفية الكلام عن المعاني الزائدة لأن الأسرار اللذيذة تشف دائما عن تواطؤ ينكتب به النص كما هو تعبيرا منسجما مع التجربة . وتبدو التجربة هنا أشبه بتعبير صوفي يضغط الألفاظ بأقصى حمولة من المعاني ، بحيث (تعجز العبارة وتقصر الإشارة ) ، ويوغل في الخفاء لتكثيف الحضور المنسي في عتمة المنام .
(أحيا بمواتِ يقظتي
كخشخاشِ " عمر الخيّام "
خادمة َ طيور ٍ
وجسدي يُؤْكـَلُ
لفرطِ المنام)
وفي الختام تشترط حياة المتعة موات اليقظة . الأمر الذي يعبر جليا عن الحلم باعتباره شكلا من الحياة ينوجد في موازاة عالم آخر تصنعه حالات النشوة وهو بالضرورة لا ينطوي على شرط الوعي الذي ربما دل على شراكه في اقتسام اللذة وبالتالي نفي التوّحد الذي يختزن الحرمان ويقطر الجسد إلى حدود غير متناهية. وتتقمص التجربة حياة مشرقية للجسد تستعيد مفهوم السلب باعتباره إغراء يرقى إلى مصاف الخدمة التامة لأفعال الخلق الذكوري تتحول بموجبه الذات إلى خادمة/جارية للطيور . ربما كان في ذلك نوستالجيا إستعادية للشرق الذي تعيش الشاعرة بعيدا عنه في (أمريكا) ، بينما تشف آفاق الرؤيا في نصها عن تأويل إشراقي يمتح من لذات الجسد إشارات تستدعي روح الشرق ، سواء في تلك اللغة الصوفية ، أو مجازات ألف ليلة وليلة أو استخدام (منطق الطير) ، وحتى في موات اليقظة الذي يمنح عالما موازيا للحلم ، من (خشخاش عمر الخيام) .
هكذا استطاعت الشاعرة اللبنانية المبدعة آمال نوار كتابة شفافة للجسد ترقى لمقام تعبيري يخترق السائد والمبتذل . وينتقل من وحدة التجربة إلى إشاعة ممتعة تنشل المعاني من على قارعة الجسد لتعيد تأويلها بلغة مشرقة وأحاسيس شفافة تتحول إلى سلطة تملك إغواء الأنثى وسحرها في الكلمات. ذلك أن سلطة الإغواء تغمر المتلقي بنبض يشف عن حالة يمكن أن يتمثل نشوتها و يستعيد ذلك الهسيس المخدر لموسيقى الجسد . إن كتابة الجسد بحسب هذا النص ، لا تحيل على محض الإغراء فحسب . بل تنطوي بالأساس على تجربة إنسانية تمنح حرية النشوة قيمة ذاتية متعالية ، وتحولها إلى إشارات حسية تختفي وراء الرموز التي ترسل للمتلقي إشارات المعاني لمخيلته . أي أنها تمارس كتابة للجسد قابلة للاستعادة والتأويل.
(15)
قراءة في قصيدة "في حبر النوم" لأمال نوّار
منصف الوداعي صالح (المغرب)
حقا النوم لا يخون اللغة كما يخون الحبر الصدور. الحبر يخون الرفات إذما تكلم منقطعا عن الحلم. القصيدة مدوية باللفظ الذي لا يولد من اللفظ . خطأ تقول القصيدة في بيانها الملحمي أن نعتقد أن اللغة تتوالد من اللغة بل تولد من حبر يسبقها بصمت السائل الرحمي في عمق الإنسان. النوم في نظري راحة الذات المصغية إلى سائلها الشفاف . نعرف أن الإنسان بدون نسك الإصغاء العميق إلى نفسه لا يمكن له أن يحرر المعنى. عندما نكون تلك الراحة التي توقظ النوم نصبح حبرا للكل المادة المحيطة بنا و المركبة لنا و نصبح قادرين على السفر الأكبر في مدارج الرؤيا . نعرف فلسفة باشلار في استكناه الراحة الخلاقة التي تجعل من الإنسان حبر الحبر . الحبر أيضا في روح القصيدة هو الإحساس … و النوم هروب من اللغة المنفصلة عن الحلم و هو أيضا بحث عن اللغة القديمة، اللغة الأصل التي من خلالها فقط يمكن للصدر و للنفس أن يتجددا. يجب التأكيد على شيء جوهري في القصيدة، النوم في راحة الإحساس لا يجمد الماء و النار. الراحة ليست إلغاء الضد ولكن تحييد الجمود في ذاته . عندما تتحدث القصيدة عن اللغة القديمة في عصور النوم تستطرد كلمة التمزيق التي بها تتحرر في حدود واضحة براحة باشلار و تحتضن في حدود غير واضحة المعنى التراجيدي، الباسكالي pascalien للحياة. بعض الفلاسفة يسمون السائل الرحمي في عمق الإنسان الحدس. وأسميه أنا أيضا الحدس مع إضافة بسيطة في سمك الكلمة او الفعل بمدلوله التيولوجي théologiqهذه الإضافة هي نفس الروح . يتعلق الأمر إذن وبدون مفاجأة بالاكتشاف الكانطي : الحدس المتعالي l’intuition transcendantale في كل حمو لتها الروحية المتحررة. عندما نرجع إلى القصيدة في المعاني الرمزية للنوم يتضح لنا جليا أن النوم هو المدلول المتعالي للروح وكحلقة تركيبية تابعة ان الحبر هو المدلول المادي للحياة و الوجود . لا تركز القصيدة على العلاقة الثنائية بقدر ما تركز على الجدلية و الاحتواء. كلمة الفخار في القصيدة تبين الإنسان الشامل الذي يمزق إنسانيته ليس انتحارا و لكن توليدا لذاته و من هنا يتضح أن التمزق هو المعايشة العميقة للذات في الاحتواء ( l’immanence) في اللغة الفلسفية . و في التعالي … التمزق هو شرط ما يسميه الفيلسوف الألماني هوسيرل تجاوز الذات و أسميه صنا عة القدر . أحب أن اختم هذا الحديث بالقولة الرائعة للفيلسوف الألماني هايدغر: ” الإنسان وحده وجود لأنه وحده نشوة الذات .extas بعد سبعة عشرة كلمة، بعد هذا العدد الكثيف والثقيل بالرمز وبالمعنى التيولوجي تأتي أهم كلمة في رأيي بشكل قوي ولكن بدون استقلالية تركيبية و خصوصا بدون كيان مستقل entité . هذه الكلمة هي ” جنين.” تأتي مرتبطة بالنار دلالة على العمق الوجودي الذي أرهصها وتجسدها في كلمة التمزق… لا يمكن في نظري أن نتصور أانطولوجيا التمزق خارج علاقة السيطرة، علاقة الانحباس. القصيدة ليست وهم الحرية المطلقة في النوم ولكن عملية تخصيب قاسية للانحباس الذي يتكرر في القصيدة بألفاظ متعددة : الصدر، العمق، التمزيق… بعد الجنين كلمة النار، و العد تسعة عشر … ” عليها تسعة عشر ” . تذهلني المفاجأة وتصعقني رائعتي و لكني لا أومن بالصدف بل أضحك من القولة التي تقول إن الجمال هو الانسجام بين الصدفة و الخير… هذا الجمال إن استعصى النفي فإنه يبقى دائما على هامش المعنى الحقيقي للجمال (الإبداع) بدون روح … أو كما تقول الشاعرة بدون حبر… هنا أطرح سؤالا : هل كل ما سبق من الكلمات هي ملائكة النار؟ لا أظن ذلك . كل ما سبق نوم يأتي بلغة أركيولوجية archéologique تتجاوز اللفظ، تتجاوز اللغة، تتسامى، تتعالى في الفطرة كمعين الصمود لتبقى اللغة لغة . و لماذا نبدع ؟ بكل بساطة لتبقى اللغة لغة . لتبقى اللغة شعلة ويبقى جنين النار جنينا. أركيولوجيا اللفظ عند الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكولا تتجاوز التاريخية الرمزية للدلالة في إطار الاكتشاف الحسي و العقلي للإنسان . عندما نرجع الى القصيدة نجد المعنى و الإنسان أكبر من ذلك بكثير . نجد الإنسان ـ الجنين بتلك الذاكرة النومينية numen أي الروحية التي نسميها الفطرة . الطينة الأولى التي انتشت بروح الإله . نجد القصيدة محاولة لقراءة تلك الذاكرة الخالدة التي لا ينطقها إلا نبي أو ملهم من طينة أمال نوار. ما معنى أن نلهم ؟ ما معنى الإلهام ؟ أن نصبح حبرا تقول القصيدة نسري بالرؤيا في اللاممكن، في المستحيل بين حدود الروح و الجسد، حدود منقبضة و منفلتة في آن واحد . أن نبدع دليل التحول métamorphose من الصمت إلى الكلام . أن نحقق شمولية الذات بالتمرد على اللغز و جعله حبرا جامحا في الحياة والذاكرة والموت … والتمرد على اللغز هو التمرد على الذات : يمزق قلبه، يتقد... لمن يقرأني في روح نوار أقول له باقتضاب يخيفني كما يخيفني الإمتداد أن نوار هذه الشاعرة التي تتبنى الحرية في التشييع الأقصى للذات هي كتابة الألم بالكيمية الزئبق… تعطي للحرية روح التنكر للذات لأنها وعت جيدا أن كنه الذات موضوعي…و كنه الحرية موضوعي، وهذا بالضبط ما تقوله استعارة أفلاطون المسماة استعارة الكهف l’allégorie de la caverne فلا يمكن للذات أن تتلذذ حريتها دون ذلك الترحال الذي يسميه باسكال باختصار المستبصر : الإنسان يعبر الإنسان…l’homme passe l’homme . هذه صورة مجازية قوية تبين ضرورة الدينامية الحية، الفاعلة في الذات لكي يتمكن الإنسان من اختراق ما يسميه إرنست بلوش ernst bloch مقاومة الموضوع . إن اقتحام سمك الموضوع من خلال الترحال، السفر هو سر ا لرقة اللامتناهية التي تجسد ثراء الحرية في شعر أمال نوار…لا يجب أن ننسى دور الألم في هذا السفر…دور الألم في زئبق الحرية. تكتب أمال نوار منافذ السفر لأن الزئبق في روحها كهوة باسكال abîme . بقدر ما تروضه يتفلت . بقدر ما تراوده يستعفف ، حلم في عتمة النهار، من سينتصر، إرادة ترويض الزئبق، إرادة قراءته و تحويله من أجل أن ينكشف لذاته بسخاء يحول ماهيته الى حبر ألكيمي يتحقق فيه الذوبان و التطويع الميتافيزيقي و المادي للقلق . تطهير ليس قلق الروح وقلق الجسد في التتالي والتلاحق و لكن في الإتحاد، في التشارك الآني المطلق للطهارة. تطهير الروح من قلقها المستعصي الضائع في الجسد و تطهير الجسد من قلقه الغائر في الروح …توحيد القلق يمكن أن يوحد التطهير. هذه القناعة تشكل حجر الزاوية في المنصوص و اللا منصوص من شعر أمال نوار . والحق كل الحق معها في ذلك لأن الخطيئة هي مركب العصيان بين الروح و الجسد…ليست هناك براءة منفردة و فردية كما ليست هناك خطيئة منفردة وفردية. ما تبحث عنه أمال نوار بكل كيانها حدسا و روحا وجسدا و خيالا، الحدس الحسي و اللاحسي… الروح الأرضية والسماوية، الجسد المحسوس و المتحسس،اللين و الصلب، والخيال الكلي هو أن تجعل من الزئبق ضمير الذبيح الكلي من اجل أن يتحقق الخلاص في طهارة تعرف قدر البراءة … من سينتصر الشق الثاني من السؤال أعلقه مؤقتا لأنظر في علاقة السؤال بالشعر عند أمال نوار. الشعر لا تهمه بلاغة السؤال لأنه دائما يأتي السؤال من النفي... ما يهم الشعر هو لامنتهى السؤال وبلفظ آخر اللاسؤال …موريس بلانشو maurice blanchot الذي أتبنى مدرسته النقدية بعقوق الحرية، يطالب بضرورة تحويل السؤال الى تسأل questionnement من اجل أن ينتقل السؤال من معرفة التوسل الى معرفة انطولوجية مهووسة بالانتزاع …بمعرفة التواصل . أمال نوار تتجاوز بلاغة السؤال لنتقل مباشرة من الاستفهام الى الاستلهام. حيلتها في ذلك قلب السؤال و عقره و تعقيفه حتى يصبح عينا واسمة للانبهار … ما يهم الشعر في قصائد أمال نوار هي الفجوة، المنحنى الذي يحرر الانبهار من السؤال . كل شعر آمال نوار هو نفي عمودي لبلاغة السؤال . لماذا هذا النفي ؟ سبق شيء من الإجابة . السؤال نصب صخري، صنم المحدود، تواطؤ على الحدس واختزال للعفوية، السؤال هو فقط منعكس الظل الذي لايمكن ان يكون هوة حقيقية تفلق المطلق بالاقتحام الكلي، بالانصهار العنيف… فعندما نتحدث عن الفيلسوف كطاقة تهويس السؤال، نتحدث عن الشاعر كطاقة تغييبه و التنكر له… وأول ما يستعصي على السؤال هي ذات الشاعر نفسها…شعر أمال نوار لا يهمه السؤال لأنه يبحث عن كلية الظل و الضوء بسمو يتطلب في نفس الآن فناء و سرمدية الانبهار…الفناء؛ لأن الانبهار تجدد، والسرمدية؛ لأن التجدد انبهار…الشاعر يترك السؤال لقراءة الشعر و ليس لكتابته.
يأخذ الإنسان في قصائد أمال نوار صورة واحدة لكنها متكسرة الحنايا والجوانب، متعددة الأبعاد و الأنحاء. هذه الصورة تمثل الإنسان معتركا معقدا ومتكسرا fractal للزائل و العرضي . الإنسان يعترك الزوال في عدمية باطنية يجذرها الإحساس بالمصير الحتمي للقدر المنهزم أمام الموت. إن البعد التراجيدي لهيولى الموت تجعل الإنسان يندفع بعنف لانتحال مطلق ما يخلصه من إحساس التلاشي الذي يسكنه. و في غالب الأحيان لا يجد إلا التلاشي نفسه ليؤسس عليه ما يمكن ان اسميه بمركب الإسقاط : هيولى الموت تتفوق على روحانيته…مما يضع الإنسان أمام خيارين . خيار الانطباع بالعدمية بمعنى مادي خالص : تبني مبدأ الموت الإرادي le suicide او تبني الانفلات الديونيسي dionysos وهذا أسميه مبدأ الحياة العدمي او خيار تبني العدمية بمعنى روحي له ايضا اشكال متعددة أهمها الإفناء الذاتي الصوفي الذي يحول الموت من عالم مجهول و مخيف الى عالم مأنوس و متأنس به من خلال الانطباع بالموت الإرادي كفداء sacrifice . يمكن القول هنا ان مركب الإسقاط يبقى في كل الأحوال تشخيصا إن لم اقل تأنيسا humanisation راديكاليا للوجود و للمصير أيضا … السؤال الذي يطرح نفسه هنا : أين مكان أمال نوار من هاذين الخيارين؟ الصمت يبقى طوفانا . الصمت أيضا يبقى خيارا راديكاليا للوجود و المصير لأنه قادر على خلق التحول …تحولا لا زمانيا و لكنه انساني . يقول موريس بلانشو :” الزمان تحول الزمان”…التحول بمعنى الانقلاب، وأقول الصمت تحول الإنسان…انقلاب الذات على الذات من اجل الإنسان. الصمت هو الثورة اللامرئية على المفتعل وبذلك هو ثورة الثورة من أجل التميز …منذ مدة و انا أجادل في صمت قولة جيل دولوز التي مفادها : المفتعل هو البنية التي تضم الاختلاف في ذاته la différence …سأقترب منه أكثر وأضيف الاختلاف الجوهري . اذا فهمنا أن الذات هي بنية المفتعل تطابقا مع النفي البنيوي و التاريخي لمنطق الحداثة التي تفصل بين الذاتي le subjectif و الإنساني l’humain نجد في قولة دولوز حقيقة كبرى تقول المفتعل بنية التميز لأن المفتعل بنية الذات بمعنى الرغبة le désir . نفهم من هذه العلاقة بالتلاحق العام أن الصمت هو رغبة ذاتية وهو بذلك أقرب الى جوهر الذات من الخاصية الموضوعية لحقيقة الإنساني l’humain . يبقى أن نضيف أن الصمت هو ثورة الذات على المفتعل …الشعر في هذا الإطار ـ لا داعي لتنظير انتمائه على الأقل في هذه العجالة، هو ثورة الرغبة على المفتعل من اجل الذات و الإنسان…يأتي الشعر في كل هذه العلاقات المتراكمة بمعجزة كبرى توحد الإنسان : يجعل من الصمت حاجة جوهرية في ذات الرغبة من أجل تقليص و إلغاء المسافة بين الذات و الإنسان . يصعب علي أن أتنكر لأستاذي في الحلم و الروح باشلار و لكن لمقتضيات الاستنباط توابع ضرورية تستدعي مني التنكر، تنكرا حالما، لأبين حقيقة الإنسان الفردي و حقيقة الفرد الإنساني . أقول ليس هناك داعيا للقول ان الإنسان هو كائن الرغبة و ليس الحاجة …يمكن أن نكتفي دون إخلال بالعمق و الحقيقة بالقول أن الإنسان هو كائن الاستشعار الشمولي لذاته و حاجته…و الشعر هو تجسيد الرهبة في الحلم و السفر من أجل استشعار الشمولية القادرة في نفس الآن على تنحية و تزكية المفتعل…يمكن لنا في نفس المنحى بارتباط مع الشاعرة الكبيرة أمال نوار أن نقول بعبارة التطهير الراديكالي …و كل شعرها يجب أن يقرأ من زاوية الاقتراف الراديكالي للتطهير. سأقتضب سفري هذا في العلاقة بين المفتعل و الشعر لأعود إلى مفهوم الألم في شعر أمال نوار. كنت دائما أترقب ولادة أنثوية عربية تكسر فحولة الوأد…ولادة أنثى من طراز سيمون فايل simone weil . كنت اقترف الترقب كما تقول شاعرتنا الكبيرة و انتظر قي أسفار العرب سيمون فايل العربية من أجل ان ارى قبل موتي الوأد ينبعث ما خلده الفيلسوف الألماني جوته ك mater glorisias أو الأنثوي الخالد . عندما قرأت لأول مرة قصيدة “أغمض علي القلب …” رأيت مهديي يتحول الى أنثى خالدة في تجربة الاستثناء. الألم هو كل اثر للنار على جسم العارض l'éphémère. هو كل أثر للنار يصبح روحا يتقمص بها الزائل معنى ذاتيا لوجوده. يتقمص بها الانبهار بذاته . يتقمص بها انبهارا صميميا قادرا على قراءة اللغز في التباساتة الناذرة و العسيرة . قادرا على قياس المستحيل و عبره و جعله علامة ثابتة في العارض : إحلال المستحيل من اغترابه … هذا الألم هو ألم أمال نوار… ألم مهووس بالمستحيل في جدلية الصخر والنار. الصخر في ماهية النار حب …مسافة الإختراق لصخر المستحيل و النار في ماهية الصخر صمت . الجدلية بين الإختراق و الصمت هو ألم أمال نوار. هذا الألم يخترق بروح الاستشهاد ألمه . وفي عمق الحياة الاستشهاد في روح الزائل أكبر من الاستشهاد في روح المطلق…يجب التأكيد هنا على شيء مهم: في هذا الغور الخارق ليس هناك مجال للمنطق. المنطق الوحيد القادر على قراءة روح أمال نوار هو قراءة سطح النار بعينين متفتحين بزهو الإصطلاء، بكبرياء الاحتراق، بعبقرية النار…يقول ألبان لوفغان عن هولدغلين : ”هولدغلين افتتان بالآني “. الافتتان بالآني هو افتتان بالمطلق لأن الآني قنطرة الانفصال عن الزمان. أمال نوار لا تتكلم لغة المطلق المنفصم ولكن لغة المطلق المنساب، المطلق الانسيابي ـ رمزية الماء و السائل الرحمي في شعرها يبين ذلك ـ الذي يشق النار افتتانا بالعرضي…أمال نوار هي عمق النار المفتون بالزائل و يمكن أن أضيف بالسائل. لم تعذبني كلمة في قصيدة “حبر النوم” كما عذبتني كلمة “حجر” . فاجأتني كثيرا لأنها انشقت عن حدسي بل و حدس القصيدة نفسها…هذه الكلمة لم تخرج من خيال الجمال . هي استثناء في القصيدة لأنها خرجت من خيال الألم لتجعل الحجر منبع النار …ليس هناك أكثر احتراقا بالشمس من الحجر. أتكلم عن الحجر في عمق أمال نوار . و يستحيل على الهواء أن يخترق الصخر. هل يستحيل على النار ؟ الجواب في عمق البركان . نرى الآن أن نسق المحتمل عميق و نسق مركب الإسقاط صريح … أمال نوار لم تعترض للنار اعتباطا …تتعرى للنار بلهفة جسد يتكنه العطش من أجل أبدية النار . و نرى هنا أيضا عمق اختيار الزائل من أجل العطش…ـ يبدو هنا ملحا البحث في العلاقة الإتيمولوجية للزوال بالأزل . أترك هذا الأمر لموعد آخر. كل روح آمال نوار اجتراح النار و كل جسدها ليس إلا ذريعة اكتواء . مشيق الظل، نحيف السطر، كثيف العطش و كله مطر، سحابة هف، فحيح و لفيف . حرف ناعم و كأن بو جوده الحريري يريد أن يكون مؤامرة نبيلة مع النار و العطش لتكون أمال نوار روحا للنار. كل النار كيان السطح كالزائل تماما. النار بطبيعتها اجتراح السطح و اجتراح العطش . احتقان السطح بالعطش . أتأمل على جسم نوار احتقانا لا يتهم أحدا … لأن النار لا تتهم أحدا . هل انكشف الأجيب.التغز؟ لا أملك أن أجيب. و لكني أستريح من موضوعي هذا بحقيقتي هذه: ليس هناك في المصير و القدر عمقا ناريا أقوى من عمق أمال نوار. ليس هناك اتحادا أعمق من اتحادها بالنار. عندما يقول المرء أنا لست شيئا يصبح كما قلت في قصيدة بعنوان ” تلاحق” حدس الذات الذي يستشعر الحقيقة من روحها . ينفجر المعنى في تلاشي الذات و تتلاشى الذات في انفجار الجوهر، هذه الحقيقة الروحية تتجسد بشكل فارق و مثير في شعر أمال نوار . تتجلى في الخيال روحا للخيال يمكن المعنى من السفر الاستثنائي في الذات لدرجة تصبح الحقيقة تلك الكلية التي كلها حضور و في نفس الوقت كلها تمنع عن الحضور. أسميت التمنع عن الحضور في الحضور في موضع آخر اللاملموس l’insaisissable . أثارني كثيرا في شعر أمال نوار قدرتها على تبني الحضور الصارخ حد العنف الاستشهادي في عمق متحرك أسميه رغبة التخفي . جدلية التكشف و الاختفاء في خيال خصب مهووس بالحركي الأفقي. الأفق يمثل تلك العلاقة الحميمية لأمال النوار بالحلم . من خلال الأفق تتمثل أمال نوار حرية الإتحاد السرابي للصراعات الكامنة بداخلها . يمكن أن نقول إن الإسقاط المنقبض للنفي من خلال الأفق يجسد الإسقاط التحرري للحلم في بنية مركبة للخيال جوهرها الإتحاد السرابي مع الذات . هناك إذا نوع من تسريب الذات عبر الخيال الناري في اتحاد الأفق . نستشف من هذا التسريب وجود سرار عميقة لغياب ما، غياب ليس ككل غياب في روح أمال نوار . كنت كتبت قصيدة أسميتها السفر و أحس الآن و كأني كتبتها بروح أمال في أفق أمال: كثيرون يحلمون كثيرون يسافرون في كل ذاكرة حلم وسفر و في ذاكرتي شقاق … في حلم وسفر و ذاكرة أمال شقاق على هيئة اتحاد مصيري و جوهري مع الأفق. أمال تبحث عن أثرها الذي هو حنين الطفولة الناذر، حلم الطفولة بدون إسقاط، فقط بروح الغياب البريء الذي لا يحتاج الى حدس الذات لأن كل الطفولة هي حدس فقط …في عمق هذا الحدس الساكن، الوادع كانت هناك يقظة ما في حلم ما ـ أرجح ان يكون بين دفتي كتاب، هذه اليقظة التي أخرجت أمال نوار من حدسها الطفولي أنشأت علاقة تراجيدية لأمال بالحلم ستحدده بشكل نهائي في خيال الأفق إلا إن الغياب الأكبر هو ذاتها في ذاتها و ليس غياب الآخر. كل شعر أمال نوار يبحث عن الأثر…في يقظة لا تريد أن تكون خائنة. حلمها ليس بوفاريا bovary على شاكلة البطلة الشهيرة للرواية الأتونيمية لفلوبير و لكنه تقصي البراءة التي ضاعت في يقظة بريئة عبر الإتحاد المنفلت كذاكرة الطفولة… في الأفق تتداخل الطبيعة لتصوغ الخيط المتحرك لروح تجعل من الإتحاد أسطورتها الذاتية …كنت على حق عندما تحدثت سابقا ( و أنا أقرأ أمال بحدسي قبل عقلي ) عن محتمل الإسقاط كمفتعل دينامي وو ضعت بذلك روح أمال في عاطفتها الطفولية. المفتعل أرضية للانفعال خارج اليقين العقلي من اجل اليقين العاطفي . وليس هناك يقينا عاطفيا أكبر من اليقين العاطفي للطفولة … في أفق أمال نوار توجد روحا لطفولتها تجعلها المبدعة الناذرة للسفر و الحلم في جسم الغياب و الإتحاد… هذا الإتحاد هو الذي يتحول نارا في حب ينتشي بتجربة المستحيل في اللاملموس. لن يقدر أحد على قراءة أمال دون فيض التماهي في الحلم مع البلور . من لا يحقق الأثر الملتهب في روحه من أجل مخاض ينبض بالحياة ملؤها الفداء لن يتمكن من النفاذ الى روحها المستعصية على الثلج… أتحسس خطاها بيدي النارية فتصبح رمادا على رمادها …حبها استباق الاحتراق و لن يقدر على قراءته إلا من روحه تستبق الاحتراق . نار كنار لويس ماسينيون louis massignon لا تحتمل … لا يحتملها إلا الاحتراق نفسه الذي بقدر ما يحترق بقدر ما يحلم، بقدر ما يحترق بقدر ما ينصهر البلور و يصبح حبرا للحلم، للأفق . هنا نفهم لماذا تشكل النار رمزا خياليا للإتحاد من أجل الولادة الجديدة …من أجل الطفولة الجديدة: هناك حيث الفخار يمزّق قلبه ليظل جنين النار التمزيق يأتي في البيت انصهارا مأساويا يستعمق النار في إحساس ميتولوجي بالفداء و يأتي الفعل “ليظل” بالمعاناة المزمنة التي ينحصر بها القلب في الدلالة الجنينية للحلم، للحب، للتقمص : تقمص النار للبراءة. تقول أمال نوار من خلال البيت : لا يمكن للبراءة أن تتقمص الحب و لا يمكن للحب أن يتقمص البراءة إلا بالانصهار الذي يخرج منه الإنسان الجنين السرمدي للحب … الحب هنا لاينفصل عن الوحدة الأنطولوجية للألم . ما يشكل عند الفيلسوف الدنماركي كيركجارد تمزق الروح في الجسم ينتهي بخلاص الروح عن طريق الجسم : الألم يحرر من ذاته... نجده عند أمال نوار تمزق الروح بألم متعالي من الوهلة الأولى بلغة الفداء...بهذا يتحرر ألم أمال نوار من اليأس و القلق الوجودي الكيركجاردي بالانصهار في ألم الأمل…تحسست الخطى و تحسست الأفق فوجدت نارا كلها فداء الحب . كل الأثر، كل الفداء، كل الرماد و كل الحرية فداء الحب في روح الكبيرة أمال نوار كبر سيمون فايل simone weil في أمل الحقيقة من أجل الحقيقة. علمتني سيمون فايل أن منتهى السفر هو حقيقة واحدة للإنسان : الإنسان مصير حقيقته و علمتني أمال نوار أن الحقيقة مصير الحب …من انتصر ؟ الأملين معا في إنسان الفداء … يقول لويس ماسينيون عن ناره : ” هذه النار من الحب الأبدي، لاترحم و لا تحتمل أي صفة من صفات الدناسة، التي تجعل كل جروحنا متقدة، تتعمق تردداتنا، و ضعفنا و نزعات رفضنا، هذه النار ستجعلنا في آخر العمر نقف أمامها لنعرف حكمها فينا ” . هذه النار الروحية للويس ماسينيون تتحدث عن نوع من التطهير في تقابل منصهر، في تقابل صراعي بين الحب الداخلي و الحب العلوي . هناك نوع من إفناء الذات في الأثر عكس الفلسفة الروحية التي ينصح بها ابن عربي : تغييب الأثر المادي من أجل الأثر الجوهري ليتحقق السكون الأبدي بدون احتمال الرجوع … أقوم بهذه المقارنة لأبين العمق العميد لنار أمال نوار في تجلياتها الروحية . نار أمال نوار تتقمص الحب الأبدي في تماه أنثوي روحي لا يجزأ و لا يقطع الأثر . فالحب بالنسبة لها هو الأثر على الجسد ينفذ الى شغاف الروح ليعرج بالجسم و الروح معا الى اتحاد أبدي موسوم بالذاكرة الحية التي لا تعرف الموت . فأمال نوار هي مسيحة النار من أجل الذاكرة المخصبة بالإتحاد بين الروح و الجسد في الحب . حقيقة هناك العديد من علامات الرغبة في التلاشي في قصائدها تتقمص خصوصا استعارة النفس و الهواء ….و لكني أرى فيه التلاشي في الأثر و ليس تلاشي الأثر. و تختلف أمال نوار عن لويس ماسينيون بتقديس الإتحاد في الحب و هي بذلك لا تتحدث عن التطهير القسري و عن الغفران la rédemption انطلاقا من انتصار جوهر الجسد على جوهر الروح أو العكس… كنت قلت سابقا أن الأسطورة الذاتية لأمال نوار تتجلى في الإتحاد و أضيف الآن الإتحاد الرحمي الذي لا يبحث عن التزكية la rédimation المبددة لجوهر الجسم او جوهر الروح. بالإتحاد يستطيع الحب الانتشاء بأسراره و أسرار الكون من حوله . بالإتحاد يصبح الحب تلك المسافة الذي يتنفس فيها الجوهر الناري للألم الانتشاء العميق حد الاغتراب : يتجلى هذا في شعرها من خلال ايزوتوبيا isotopie السائل الذي هو في نفس الوقت الماء البارد و السائل البركاني la lave . في شعر أمال نوار الانتشاء هو استثناء في المفتعل . الاستثناء في الانفعال . الاستثناء في التفاعل …الاستثناء في الفعل … استثناء يمشي أثرا للإتحاد المعجزة بين الألم و النور، بين النار والنور. الإنسان هنا يتجاوز الإنسان في بلاغة باسكال تجاوز القابض لحقيقة و جوهر الإنسان : من هنا الانتصار الخفي للحب في المعاناة للامنصوص الخطاب في شعر أمال نوار. كل أثر الإنسان في الإتحاد الملحمي بالألم و الفداء هو كل الإنسان الأثر لأنه ينبثق من الحب الصادق الذي يعتق الحب... يتكرر الحلم في الصدى كما يتكرر الصدى في الأفق. و ينبع الإتحاد من الارتداد في تجاويف النار و ثنايا الموج . في المادية المنحلة بالتعدد و التكرار بالمنطق النقيض لمنطق الإتحاد من أجل اتحاد يختلف بجوهر الصراع عن الإتحاد الذي يتساكن فيه الذاتي و المغترب… في شعر أمال نوار الإتحاد هو تمحيص للصراع في الذات المغتربة بين الوجود و العدم . صيغتان من صيغ التكرار و التكوير للأفق و الحلم يؤسسان الإتحاد على الصراع الممزق المتحرك بين الرغبة في الامتلاك و الرغبة في النفي …الإتحاد هو جدلية الامتلاء والفراغ التي تتجاوز الإتحاد نفسه من أجل الصراع الذي يرسم الخطوط العبقرية لاستقلاليتها …في عمق شعر أمال نوار “أسطورة ذاتية” تتجاوز الإتحاد الى الصراع من أجل العبقرية الذاتية كإنتماء يحبر الذات جوهرا للحرية . هذا ما أقرؤه في صيغة الجمع لكلمة “نايات” …أما الجمع في كلمة “مناماتي” فيجسد الإرتماء العنيف في النفي الغير الصريح للآخر، للحجر الذي يشكل مصدر وعي اغترابي بالذات... البنية المتعددة للرؤى في عمق الإتحاد يمثل عند أمال نوار انبعاثا لرغبة دفينة أن يتحول النوم المهووس بالحبر الى يقظة مهووسة بالامتلاء الوجودي بالذات المنتصرة على الغياب و النكران . الجمع في كلمة “جرار” التي تأتي ممتلئة بالصدى تبين الرغبة في فك الاختناق في قلب الإتحاد من أجل شرود - الشرود هنا بمعنى الحرية الفاعلة للإبداع - منطبع بالتغييب فقط كتحفيز للصراع ولانتصار. الانتصار على الصمت و الإتحاد... الحبر ينساب و يكلم من خلال الفناء ( يجب أن لا ننسى العلاقة الرمزية للنوم بالموت …و الطبيعة الإفتدائية للذات الحالمة من أجل الذات اليقظة التي تمسك بمعناها كلية فيما وراء الفداء…) الحجر بعد أن وضع في أمواج نارية منفتحة على الروح و الجسد، السماء و الأرض، الواقع و الرؤى …بين المطلق السماوي لوهج الحب و المطلق الأرضي للأمل . الحبر ينساب في عمق الحجر ليكلم نواة الصمت بلغة الإختراق الممزق الذي يتعدد التمزيق و يتعدد الفداء من أجل اتحاد صميمي بالذات في عمق الحجر . يمثل الحجر في قصيدة أمال نوار مستحيل الوأد وهو بذلك أمل نواتي يرسخ في الحلم اليقظة كسفر في منتهى الألم من أجل الذات المنتصرة في كنه الحجر . أمال نوار لا ترغب في الحب أملا واثقا بالسطح، أملا سهلا بليونة التراب، بذاكرة الوأد الذي يتسنى فيه للموت أن ينسى و يتجرد من ألمه…أن ينسى فداءه و اجتراحه للمستحيل بل تسني المستحيل بالفداء المتكرر ليكون جديرا بالإتحاد الصميمي و المطلق مع العمق الأبدي للحب الذي هو وحده يحقق تجاوز الإتحاد من أجل انتصار العبقرية... من أين تنمو عبقرية هذا الحب ؟ من الفداء المسكون بالفراغ كخيار وجودي يبني الإتحاد على التحول...


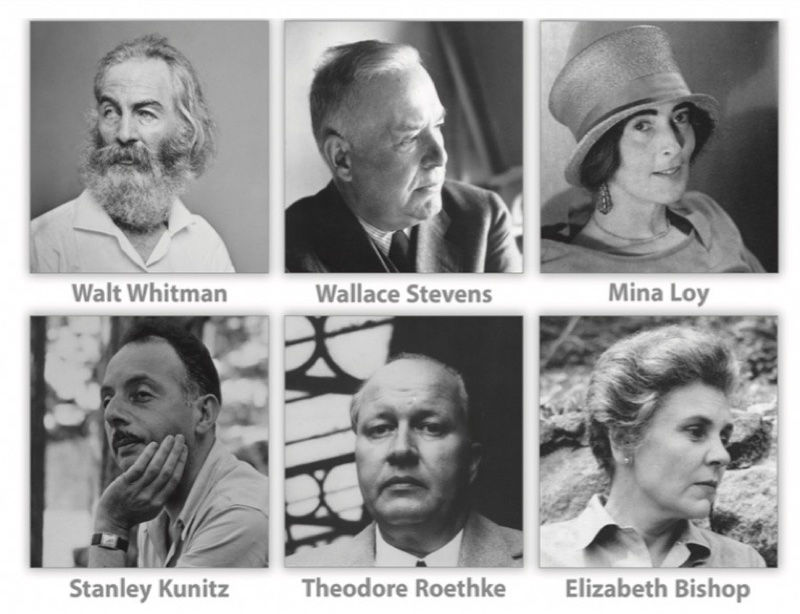

Comments